النبوة في الفكر الكلامي
Tuesday, August 7, 2012
النبوة في الفكر الكلامي
النبوة في الفكر الكلامي
الدكتور/ كمال الدين نور الدين مرجوني
رئيس قسم الدعوة
والإدارة الإسلامية
جامعة العلوم
الإسلامة الماليزية
تمهيد:
إن النبوة فضل
إلهي ومنحة ربانية، يهبها الله لمن يشاء من عباده، ويختار لها من يريد من خلقه،
وهي لا تدرك بالجد والتعب، ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة، وإنما هي اصطفاء
واختيار، وليست اكتسابا وعملا كما يزعمه الفلاسفة([1]). وهذا
الاصطفاء يوجب بذاته ضربا من الاتصال على نحو خاص فيما بين الله تعالى والنبي
المختار، إذ بهذا الاتصال يعلم النبي بنبوته ، ويتلقى من الله رسالته التي يكلفه
بحملها، والدعوة إليها، ويمثل الوحى هنا حلقة الاتصال بين الله والنبي، فهو بمثابة
الرابطة التي تربط بين السماء والأرض، ومن ثم كان الوحى والإلهام دعامة أساسية لكل
دين سماوي فمنهما صدر، وبما لهما من إعجاز فاز، وعلى تعاليمهما تأسست قواعده
وأركانه([2]). إذن
النبي هو واسطة بين الله I والبشر. يقول الإمام ابن تيمية: "ومن الإيمان به
الإيمان بأنه -محمد e- الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده
وحلاله وحرامه"([3]). فهي
الوسيلة التي عرفت البشرية من خلالها ما يتعلق بعالم الغيب، وما يجب على الخلق نحو
خالقهم، وهدايتهم إلى المنهج السليم الذي به تقوم حياتهم. وإذا كانت نبوة الرسول e قد
سبقتها نبوا غابرة وثنية، وسماوية تختلف في أنواعها ومصادرها ونظرة الناس إليها،
فإن هذه النبوة الإسلامية جاءت مصححة متممة لكل ما تقدمها من فرة عن النبوة، كما
كانت عقيدة الإسلام الإلهية مصححة متممة لكل ما تقدمها من عقائد بني الإناسن في
الإله([4]).
ومن هنا، تعد
قضية النبوة من أهم قضايا الإسلام وأكثرها حساسية، وكان الفارابي هو أول فيلسوف
مسلم عالج هذه القضية، فصاغ نظرية كاملة، بحيث لم يدع فيها زيادة لخلفائه فلاسفة
الإسلام الآخرين، وقد جاءت هذه النظرية أهم محاولة للتوفيق بين الدين والفلسفة،
وهذه النظرية هي أسمى جزء في مذهبه الفلسفي، تقوم على دعائم من علم النفس، وما
وراء الطبيعة، وتتصل اتصالا وثيقا بالسياسة والأخلاق ([5]) .
ثم جاء ابن سينا بعده مسترشدا بنظريته في النبوة، لأنه لم يكن لليونان نظرية في
النبوة يسترشد بها، فأبقى على خطوطها العامة وصفاتها الرئيسية، وتتناول بعض
تفاصيلها بالتغيير والتبديل، وتوسع فيها حتى جعلها من صميم مذهبه ([6]).
حقا قد يستطيع
العقل التمييز في بعض الأحيان بين الخير والشر، ولكنه غير قادر على استيعاب كل ما
يحيط بعد دون مساعدة الرسل، كما أن العقل محل خلاف بين الناس، فالسوفسطائية مثلا
يرون أن الإنسان مقياس كل الأشياء جميعا، ويهذا تختلف المعرفة من إنسان إلى آخر،
فما أراه أنا حقا، قد يراه غيره باطلا، وكلانا محقا بالمعنى السوفسطائي، ومن أمثلة
ذلك أن بعض الفلاسفة الذين تعرضوا ليوم القيامة من خلال عقولهم لم يتصورا أن الله
سيؤلف أجسادا سوف تحيا مرة أخرى بنفس الطريقة التي نحيا بها([7]).
ولهذا بعث
الله تعالى محمدا e نبيا ورسولا من العرب إليهم وإلى الناس كافة: ]وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ[ -سبأ: 28-. ويؤيده الله تعالى بالوحي، ويجري على يديه ولسانه
ضروبا من المعجزات والآيات البينات تدعم نبوته وأحقية رسالته وصدق دعواه. وإذا
كانت نبوة محمد e ورسالته قد حظيت منذ ظهورها بالمؤمنين المصدقين، فقد منيت
بالمعارضين والمكذبين، شأنها في هذا شأن كل نبوة ورسالة سماوية([8]).
وإننا نجد في كتب اليهود والنصاري الموجودة اليوم علامات ذلك النبي الكريم،
حيث جاء في سفر الثنية ما نصه عن نبوة محمد e: "جاء الرب من سيناء([9]) وأشرق
لهم من ساعير([10]) وتلألأ
من جبال فاران([11])،
وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم([12]).
وفي موضع آخر جاءت البشارة بنبوة النبي e في (إنجيل يوحنا)([13]) ما
نصه: "ومتى جاء المعزَّي الذي سأرسله إليكم من الآب روح الحق الذي من عند
الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء([14]).
وفيه أيضا: "إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم
معزّيًا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه
لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم([15]).
والجدير بالذكر أن ابن القيم أورد هذا النص في كتابه (هداية الحياري) بعدة ألفاظ،
وفي بعضها "الفارقليط" أو مايسمى باليونانية (Parakletos)([16]) بدل"
المعزي".
وفي إنجيل
(متّي)([17]) ما
نصه: "... لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، ويعطي لأمة تأكل
أثماره"([18]).
كما جاء في سفر التثنية أيضا: "أقيم لهم نبيا من وسط إخواتهم مثلك، وأجعل
كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي
يتكلم به بإسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم بإسمي كلاما لم أوصه أن
يتكلم به، أو الذي يتكلم بإسم آلهة آخرى فيموت ذلك النبي([19]).
فاليهود تحمل هذه البشارة على يوشع، وتحملها النصارى على المسيح، والصحيح أنها
تبشر بمحمد e.
ومن هذه
البشارات ما نصه في سفر أشعيا([20]):
"إني جعلت أمرك محمدا، يا محمد، يا قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد"
وقوله إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول الرسول e: (كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته)([21]).
وفي التوراة العبرانية في الأصحاح الثالث من سفر حبقوق وما نصه: "وامتلأت
الأرض من تحميد أحمد، ملك بيمينه رقاب الأمم"([22]).
ومن الملاحظ
أن المسائل الأساسية للنبوة التي تحدث عنها القرآن الكريم وهي:
1) حاجة البشر
إلى الرسالة، مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
2) النبوة اصطفاء
ورعاية من الله تعالى لمن يختارهم وليست اكتسابا.
3) الأنبياء
بشر، وليسوا ملائكة، يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخصائص البشرية.
4) الأنبياء
معصومون بعصمة الله تعالى لهم.
5) الأنبياء يبشر
سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقهم.
6) الأنبياء
يؤيدون من الله بالآيات التي تؤيد صدق دعواهم بما يناسب أحوال أممهم.
7) الرسالات
السماوية متحدة في أصولها.
وأما المشاكل
التي برزت في الفكر الإسلامي في هذه القضية -أي قضية النبوة- ودار حولها خلاف بين
علماء الكلام فهي:
1) ما إذا كانت
بعثة الرسل واجبة على الله سبحانه وتعالى أم جائزة.
2) وهل يحظى
الأنبياء بشرف النبوة والرسالة استحقاقا واكتسابا بميزات شخصية يفضلون بها ما
سواهم من البشر، أم أنها اصطفاء واجتباء من الله تعالى.
3) هل كل خوارق
العادات أو المعجزات التي يجريها الله تعالى علي يد النبي تصلح حجة على صدق دعواه
أم أن منها ما هو أولى بالاحتجاج به خاصة، وأن كرامات الأنبياء والصالحين التي
يعتبر بعضهاخارقا للعادة يعتقد بها كثيرون.
4) ما حقيقة
الوحي الذي هو واسطة بين الله تعالى والأنبياء.
5) قضية التفضيل
بين الأنبياء والملائكة.
وثمة ثلاثة
مواقف متباينة من حكم بعثة الرسل، هي: النفي، والوجوب، والجواز. قالت البراهمة
بالنفي والاستحالة، وقالت المعتزلة بالوجوب والحتمية، وقالت الأشعرية بالجواز والإمكان. إذن
فعلماء الإسلام انقسموا في حكم بعثة الرسل إلى رأيين:
- الرأي الأول:
منهم –السلف الأشعرية الماتريدية- قالوا بأن بعثة الرسل جائزة عقلا، فلا هي من
المحال الممتنع ولا هي من قبيل الواجب على الله تعالى. لأن الله تعالى مطلق
المشئية في أن يختار لها من يشاء، ولا يشترط في النبي شرط أو استعداد، بل هو
اختصاص محض من جانب الله عز وجل. وأن معجزات الأنبياء أقوالا وأفعالا كلها جديرة
بإثبات صدق النبي e في دعواه طالما أنها مقرونة بالدعوى ومطروحة للتحدي وتتأبى
على المعارضة. وأثبتوا على الأنبياء وإن كان يفضل بعضهم بعضا إلا أنهم جميعا أفضل
البشر. كما يقررو بعضهم بأن الأنبياء أفضل من الملائكة. وأما عن الوحي، فقالوا
بأنه ملك من الملائكة وأنه وسيلة الاتصال بين الله تعالى والنبي أو الرسول. وقد
يتمثل الوحي بشرا، وينزل في صورة محسوسة فيراه النبي مثلما رأي جبريل في صورة دحية
الكلبي([23]) .
- الرأي الثاني:
ذهب المعتزلة وغيرهم إلى أن بعثة الرسل واجبة عقلا، فهي واجبة على الله عند
المعتزلة بمقتضى بقولهم بالصلاح والأصلح والحسن والقبح العقليين تبعا لأصل مذهبهم
في العدل. وقالوا ما قاله الرأي الأول بأن النبوة اصطفاء واختيار إلهي. ورأوا بأن
الرسول لا يجب أن يكون أفضل من سائر الناس قبل البعثة، ولكن متى بعث وجب أن يصير
أفضل بسبب ما يحصل منه من التكفل والعزيمة وتوطيد النفس على الصبر وتحمل المشقة
فيما يحول دون أداء الرسالة. وذهب أكثرهم إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء([24]) .
وقبل أن نعرض
آراء المتكلمين في النبوة، فمن المستحسن التعريف بها أولا، وهي في
اللغة -كما ذكر صاحب لسان العرب- مشتقة من: "النبأ: الخبر، والجمع: أنباء،
وإن لفلان نبأ، أي: خبرا. والنبي: المخبر عن الله. قيل: النبي مشتق من النباوة:
وهي الشء المرتفع، والنبي –أيضا-: الطريق الواضح"([25]) .
ونفهم من هذا التعريف اللغوي أن للنبوة ثلاثثة اشتقاقات:
1) إما أن تكون مشتقة من النبإ،
فتكون بمعنى: الإخبار، إذ النبأ: هو الإخبار.
2) وإما أن تكون مشتقة من النبوة أو
النباوة، وكلاهما يدل على الارتفاع، فتكون بمعنى: الرفعة والعلو.
3) وإما أن تكون مشتفة من النبي، وهو
بمعنى: الطريق، فتكون النبوة بمعنى: أنها الطريق إلى الله عز وجل.
وقيل: إنها
اسم من النبأ وهو الخبر([26]) كما
قال تعالى: ]عَمَّ يَتَسَاءلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ[ -
النبأ: 1،2-. يعني: "الخبر الهائل المفظع الباهر"([27]) .
والحق أن
النبوة تشمل كل هذه المعاني، إذ النبوة: إخبار عن الله تعالى، وهي رفعة لصاحبها
لما فيها من التشريف والتكريم، وهي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع
ذلك فإن أولى هذه المعاني بلفظ النبوة، وكذلك النبي، هو اشتقاقها من النبإ، لأن
النبي e منبأ من
الله، وهو كذلك ينبئ الناس عن الله، وتتحقق نبوته بمجرد ذلك، وبهذا التحقق تثبت له
أوصاف العلو والرفعة، وكونه طريقا إلى معرفة الله تعالى.ويؤيد ذلك ما
نورد في القرآن الكريم في عدة آيات من إطلاق النبأ على الخبر، كقوله تعالى: ]بِّئْ
عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ[ -الحجر:
49-.
أما النبوة في
الشرع: فهي صفة تحدث في الشخص بعد أن يصطفيه الله عز وجل، فيخبره بخبر السماء، فإن
كلفه بتبليغه إلى الناس يكون نبيا ورسولا، وإن لم يكلف بذلك فهو نبي فقط، وهذا هو
المشهور عند العلماء -كما سنبينه-.
وأما تعريف
النبي والرسول فما يلي:
النبي لغة:
مشتق مما اشتقت منه كلمة النبوة، أي: من النبإ وهو الخبر. وقيل: النبي: هو الطريق
الواضح، لأن العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها، وسمي
النبي بذلك، لأنه علم يهتدي به الخلق إلى الله تبارك وتعالى([28]) .
والنبوة لغة كما يعرفها القاضي عبد الجبار بأنها:
"تستعمل في كل رفعة، ومنها أخذنا كلمة النبي التي تفيد الرفعة كذلك"([29]). والرسول
في اللغة: هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض([30]) .
والرسول مشتق من الإرسال، ومعناه: البعث والتوجيه، فإذا بعثت شخصا في القيام
بمهمة، فهو رسولك. قال تعالى حكاية عنملكة سإ: ]وَإِنِّي
مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ[ -النمل:
35-. ويجمع الرسول على أرسل، ورسل، ورسلاء، وسموا الرسل بذلك، لأنهم مبعوثون
وموجهون من قبل الله عز وجل، لتبليغ الخلق أمر الله ووحيه([31]) .
أما تعريف
النبي والرسول شرعا، فاختلت أقوال العلماء في تعريفهما، فقال ابن تيمية:
"النبي: هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله إليه، فإن أرسل مع ذلك
إلى من خالف أمر الله، ليبلغه من الله إليه، فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل
بشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي، وليس برسول، قال
تعالى: ]وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا
إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ[ -الحج:
52-.
وقوله: (من
رسول ولا نبي)، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو
الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله، كنوح ... ثم ذكر أن في
الآية دليلا على أن النبي مرسل، ولا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم
بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه الحق كالعالم([32]).
ويفهم من كلام
ابن تيمية السابق، أنه يفرق بين النبي والرسول، فالرسول من أوحي إليه بشرع وأمر
بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فالرسول أخص من النبي.
وعلى أية حال
فإن الرسل كثرت وتبلغ عددهم إلى ثلاثمائة عشر، وقلت الكتب إذ هي التوراة،
والإنجيل، والقرآن.
وفيما يلي
البيان بالتفاصيل لآراء علماء الكلام (الإباضية، والمعتزلة، والأشاعرة،
والماتريدية، والظاهرية) في حكم بعثة الرسل، والفرق بين النبي والرسول، وحقيقة
النبوة، والعصمة والمعجزة.
المبحث الأول
النبوة عند الإباضية
حكم بعثة الرسل
رأى
الإباضية إمكان بعثة الرسل وجوازها، وذلك لأنه من الأمور الممكنة، وكل ممكن يجوز
في حقه تعالى فعله أو تركه، فلا وجوب عليه ولا استحالة عليه في ذلك، وقد قرر بذلك
الثميني في كتابه (معالم الدين) قائلا: "ذهب أصحابنا والأكثرون إلى أن
الرسالة ممكنة، تفضل بها مولانا عز وجل على من اصطفاه من خلقه"([33]).
وبهذا خالف الإباضية المعتزلة لقولهم -أي المعتزلة- بأن البعثة واجبة على الله
تعالى لوجوب الصلاح والإصلاح على الله، ووجوب اللطف عليه تعالى، فإنه رحيم بعباده
رؤف بهم فما علم الله أنه نافع لعباده وأصلح لهم في الدنيا والآخرة، وجب على الله
مراعاة هذا الأصلح وأن يحققه لهم، وأن يعلمهم به، وأن يمكنهم من فعله وإزاحة العلل
بالألطاف. وفيما يرى المعتزلة، فإن عدم إرسال الرسل يعني الإخلال بالواجب من قبله
تعالى([34]).
وقد
انتقد الإباضية رأي المعتزلة بوجوب بعثة الرسل من خلال إبطال أصل المعتزلة في
التحسين والتقبيح، ونقده لفكرة الصلاح والأصلح([35]).
الفرق بين النبي والرسول
فرق
الإباضية بين النبي والرسول، فرأوا أن النبي هو رسول بشرط التبليغ ما أوحي إليه،
أي أن النبي e هو الذي
اختص من بين البشر بما أوحي إليه، ولكنه لم يؤمر بالتبليغ. أما الرسول فهو المختص
بالوحي والتبليغ جميعا، فالرسول إذن أخص من النبي e، وكل رسول نبي من غير العكس، وأكد بذلك
الثميني قائلا بالتمييز: "وعليه أصحابنا والأكثرون"([36]).
وأنكروا القول بالتفرقة بينهما بسبب ما قيل عن النبي e والرسول أنهما متباينان، وأن الرسل هم
أصحاب الكتب والشرائع، والنبيون هم الذي يحكمون بالمنزل على غيرهم مع أنهم يوحى
إليهم، فهو باطل. إذ لا يلائم ما في القرآن، فإنه قد وصف فيه سيدنا محمد e بالنبي
والرسول معا، وكذا قال سبحانه في كل من موسى وإسماعيل: (وكان رسولا نبيا)
-مريم:54-([37]).
ويتضح
مما سبق أن الإباضية يفرقون بين النبي والرسول لاختصاص الرسول بالتبليغ دون النبي،
وأما التفرقة بسبب أن الرسول هم من أوتي كتاب وشريعة، فلا يجيزون بذلك.
حقيقة النبوة
ذهب الإباضية
إلى أن النبوة إصطفاء وإختيار، وهي منة إلهية امتن بها الله على الأنبياء والمرسلين
فلم يصلوا إليها بكسب ولا جهد، ولا كانت ثمرة لعمل أو رياضة للنفس قاموا بها كما
يزعم بعض الفلاسفة المشائية كالفارابي وابن سينا، حيث ذهبوا إلى أن النبي هو ذلك
الشخص الذي منحه الله تعالى مخيلة قوية تمكنه من الاتصال بالعقل الفعال أثناء
اليقظة وفي حالة النوم. ويهذه المخيلة يصل إلى إدراك الحقائق التي تظهر له على
صورة الوحي أو الرؤيا الصادقة، وليس الوحي إلا فيضا من الله عن طريق العقل الفعال،
كما أن هناك أشخاصا أقوياء المخيلة، ولكنهم دون الأنبياء. فلا يتصلوا بالعقل
الفعال إلا في حالة النوم. وقد يعز عليهم أن يعربوا عما وقفوا عليه. أما العامة
والدهماء فمخيلتهم ضعيفة هزيلة لا تسمو إلى درجة الاتصال لا في حالة اليقظة ولا في
حالة النوم، وفي ذلك يقول الفارابي: "ودون الأنبياء من يرى جميع هذه الصور
الشريفة في يقظته وبعضها في نومه، ومن يتخيل في نفسه هذه الأشياء كلها، ولكن لا
يراها ببصره، ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط، وهؤلاء تكون أقاويلهم التي
يعبرون بها أقاويل محاكية ورموزا وألغازا وابدالات وتشبيهات، ثم يتفاوت هؤلاء
تفاوتا كثيرا"([38]).
إذن، فالنوبة عندهم شيء مكتسبة وأن من هذّب نفسه بالخلوة والعبادة، وأخلى نفسه عن
الشواغل العائقة عن المشاهدة، وراض نفسه، وهذبها، تهيأ للنبوة.
وفي مناقشة
هذا الرأي الفلسفي للنبوة قام الثميني -أحد أئمة الإباضية- بالرد على من قال بأن
النبوة أمر مكتسبة، فرأى أن ما يزعمه الفلاسفة من أن الصورة -أي صورة الملك- التي
تخاطب النبي e، لا وجود لها
في الخارج، وإنما هي من أفعال الخيال، وأن الذي يراه في النوم الواحد منا من أشخاص
تحدثه وتخاطبه، لا وجود لها في الخارج، وإنما شيء متخيل، فيحدث للنبي e في
اليقظة ما يحدث للواحد منا في النوم، وهذا الرأي كفر وتكذيب([39]).
العصمة والمعجزة
تحدث
علماء المذهب الإباضي عن المعجزة بأنها فعل الخارقة للعادة، المقارن لدعوى
الرسالة، يتحدى به قبل وقوعه، ويعجز من يبغى معارضته عن الإتيان بمثله. أما معجزات
محمد e فلا يحاط
بها، وحاول بعضهم حصرها، فقيل: ألف، وقيل عشرة آلاف، وقيل لا يمكن حصرها، وفي
مقدمة معجزاته القرآن، فإذا علم صدق الرسل بدلالة المعجزة، وجب تصديقهم في كال ما
أتوا به عن الله سبحانه، إذ يستحيل منهم الكذب عقلا، والمعاصي شرعا، لأنا مأمورون
بالاقتداء بهم، فلو جازت المعصية منهم، لكنا مأمورين بها، بخلاف قوله تعالى: ]إِنَّ اللهَ
لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ[ -الأعراف:28-. وبهذا يعرف وقوع الفواحش منهم على نحو ما يقع من
غيرهم([40]).
وعن وقوع
المعاصي قبل النبوة يقرر الإباضية بعصمة الأنبياء من الكبائر على كل حال دون
الصغائر، وأما بعد النبوة فأجمعوا على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام، لأن
المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه عن الله سبحانه، فلو جاز تعمد الكذب عليهم
لبطلت دلالة المعجزة على الصدق، وفي وقوع النسيان والغلط فمنع جمهور الإباضية لما
فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة، وجوزوه بعضهم، ويرى الثميني عدم جواز وقوع
المكروه من الرسل، فالحق أن أفعالهم دائرة بين الوجوب، والندب، والإباحة، وليس
وقوع المباح منهم بحسب مقتضى الشهوة كوقوعه من غيرهم، فإنهم -لعظم معرفتهم بالله،
وخوفهم منه، واطلاعهم على ما لم يطلع عليه غيرهم- لا يصدر منهم المباح، إلا على
وجه الطاعة والقربة ونحو ذلك مما يليق بمقاماتهم الرفيعة، وإذا كان أهل المراقبة
من أولياء الله تعالى بلغوا في الخوف منه تعالى، ورسوخ المعرفة، ما منعهم من أن
تصدر منهم حركة أو سكون في غير رضاه، فكيف بأنبيائه ورسله([41]).
المبحث الثاني
النبوة عند المعتزلة
حكم بعثة الرسل
يرى المعتزلة
أن بعثنة الرسل واجب لإقامة الحجة من الله على الناس، ولو لم يفعل لأخل بما هو
واجب عليه. ويشرح القاضي عبدالجبار رأي المعتزلة في وجوب بعثة الرسل في كتابه
"المغني في أبواب العدل والتوحيد" قائلا: "اعلم أنه إذا صح أن الذي
يبعث له الرسول، تعالى هو ما ذكرناه من تعريف المصالح .. فلا شبهة في أن ذلك واجب
كما أنه إذا كلف المكلف فلابد من أنه يجب التمكين وإزاحة العلل([42])"،
وفي نفس الكتاب يقول: "يجب على كل حال بعثة الرسل؛ لأنه لا فرق بين أن يحتاج
إليها في الشروط التي لا تتم العبادات إلا بها، أو في نفس العبادات"([43]).
وورد كلامه في "شرح الأصول الخمسة: "ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به
ذلك ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين ما لا يكون ذلك، فلا بد من أن يعرفنا الله
تعالى حال هذه الأفعال كي لا يكون عائدا بالنقص على غرضه بالكتليف. وإذا كان لا
يمكن تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيدا بعلم معجز دال على صدقه فلا بد
من أن يفعل ذلك، ولا يجوز له الإخلال به، ولهذه الجملة، قال مشايخنا: إن البعثة
متى حسنت، وجبت على معنى أنها متى لم تجب قبحت لا محالة، وأنها كالثواب في هذا
الباب فهو أيضا مما لا ينفصل حسنه عن الوجوب"([44]).
إذن، فبعثة
الرسل عندهم واجبة على الله بمقتضى قولهم بالصلاح والأصلح والحسن والقبح العقليين.
وأن عدم إرسال الرسل يعني الاخلال بالواجب من قبله تعالى، وهكذا إذا تقرر عندهم أن
ما يدعو إلى الواجب واجب، وما يصرف عن القبيح واجب أيضا، وأن عكس ذلك قبيح، أي ما
يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح.
والجدير
بالذكر أن قضية بعثة الرسل عند المعتزلة لها اتصال وثيق بأصل من أصول المعتزلة
الخمسة وهو الأصل الثاني: "العدل"([45]).
ووجه الاتصال يكون في أن الكلام فيها كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق
بهذه الشرعيات، فلا بد من أن يعرفناها، لكى يكون مخلا بما هو واجب عليه، ومن العدل
أن لا يخل بما هو واجب عليه([46]).
ومن هنا قرر المعتزلة أن الكلام في النبوات فرع عن الكلام في باب العدل ومتصل به.
وإضافة إلى
ذلك فإن المعتزلة اعتبروا النبوة لطفا حين بعث الأنبياء، لأن المؤمنين ما كانوا
بغير بعثتهم يؤمنون([47]).
أي أن التبليغ الذي
يأتي به الأنبياء تشريعاً من اللّه يأتي موافقاً لما يحكم به العقل، بمعنى أنه لا
يمتنع عند العقل .و اللطف واجب
لأنه هو الذي يحصّل غرض الشارع المكلف .و متى لم يجب
لزم نقض غرض الشارع المكلف .
وأما ما
يرميهم به خصومهم من إنكار النبوات في مثل قول يحيى بن أبي الخير العمراني في
كتابه (الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية المشبهة الأشرار): "المعتزلة:
وهم موافقون للبراهمة في قولهم إنهم يستغنون بما في عقولهم عن إرسال الرسل"([48]).
فليس إلا سوء فهم هؤلاء عن المعتزلة قولهم، فالجبائي مثلا يقول في بيان وجه
المصلحة واللطف في بعثة الأنبياء إنها -في حكمته تعالى- تتمة للشرع ببيان ما أجمله
من ركاز الواجبات العقلية([49]).
وليس هذا البيان لمصلحة البعثة سوى حجة القرآن العقلية في جمعه بين دليلي الشرع
والعقل في مثل قوله: )وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ( -الملك: 10-. ومطالبته الدائبة لأصحاب المعتقدات القديمة بما
في العقل من برهان على أقوالهم بمثل قوله: )أَمِ
اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن
مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم
مُّعْرِضُونَ( -الأنبياء: 24-. الذي تأوله المعتزلة بأنه دليل على أن الحق
يحتاج إلى برهان، وما لا برهان فيه فهو باطل. فليس اتهامهم للمعتزلة إلا غفلة عن
منطوق هذه الحجة القرآنية العقلية الكلامي، الذي أخذه المعتزلة من أنه لم يكن في
العقل ما يمكنه من إدراك الواجب الشرعبي، للزم إفحام الأنبياء، ولزم كون الشرع
إجبارا. وبذلك يبطل ما في القرآن من وعد ووعيد، ويفوت التكليف غرضه فلا يصح منه
شيء. وعلى ذلك فقد كان تعبير القرآن عن وجه المصلحة في بعثة الرسل يشكل دليلا من
أهل أدلة المعتزلة على صحة قولهم بحرية الإرادة. فلو لم يكن المكلف مختارا، لما صح
كون الأنبياء مبشرين ومنذرين، بما معهم من أصول العقيدة ليقوم الناس بالعدل في
عقائدهم وسلوكهم([50]).
الفرق بين النبي والرسول
النبي كما ورد
في كتاب (المغني في أبواب التوحيد والعدل) للقاضي عبد الجبار أنها": رفعة
مخصوصة يستحقها الرسول إذا قبل الرسالة و تكفل بآدائها و الصبر على عوارضها"([51])،
ومن هنا رد المعتزلة لفظة النبي لغة إلى النبوة و النياوة بمعنى الارتفاع و
الارتقاء.
وإذا كان
جمهور أهل السنة يرون التفرقة بين النبي والرسول من حيث إن الرسول يختص بشرعية أو
بكتاب أو بقوم يرسل إليهم، وأن النبي أعم من ذلك([52])،
فإن المعتزلة لا يفرقون بين النبي والرسول إلا في الاشتقاق اللغوي فقط، فالنبي
والرسول مترادفان، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، وإنما جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر، والرسل
تعم الملائكة والبشر. يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "إنه لا فرق في
الاصطلاح بين النبي والرسول"([53]).
والدليل على ذلك كما بينه القاضي عبد الجبار: "إنَّ لفظي النبوة والرسالة
يثبتان معاً، ويزولان معاً في الاستعمال حتَّى لو أثبت أحدهما، ونُفي الآخر لتناقض
الكلام، وهذا هو أمارة إثبات كلتي اللفظتين المتفقتين في الفائدة"([54]).
وقد رد المعتزلة على من خالفهم من الأشعرية القائلين بالفرق بين النبي والرسول
استدلالا بقوله تعالى: )وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ وَلاَ نَبِيّ إِلاّ
إِذَا تَمَنّىَ أَلْقَى الشّيْطَانُ فِيَ أُمْنِيّتِهِ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا
يُلْقِي الشّيْطَانُ ثُمّ يُحْكِمُ اللّهُ آيَاتِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( -الحجة:52-.
حيث عطف القرآن الكريم النبي على الرسول، والعطف يقتضي المغايرة، فيجب أن يكون
هناك فرق بينهما، فأجاب المعتزلة: "إن الكلمتين متفقتان في المعنى، والذي يدل
على ذلك هو أنهما يثبتان معا ويزولان معا في الاستعمال حتى لو أثبت أحدهما ونفى
الآخر لتناقض الكلام. وهذا أمارة إثبات كلتى اللفظتين المتفقتين في الفائدة"([55]).
ويعني المعتزلة بهذا الدليل هو اتفاق المعنى بين لفظي نبي ورسول، فخاطب الله تعالى
محمداً مرة بالنبي، ومرة بالرسول فدلَّ على أنَّه لا منافاة بين الأمرين، وقوله
تعالى: )وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مّن نّبِيّ إِلاّ أَخَذْنَا
أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضّرّآءِ لَعَلّهُمْ يَضّرّعُونَ( -الأعراف:
94-. وكأنهما لفظان مترادفان، بحيث لو أثبتنا لفظا وفي نفس الوقت نفينا اللفظ
الآخر، فإن الكلام لا يتسق، كما لو قلنا مثلا: "أن محمدا e نبي وليس
رسولا، أو قلنا: إنه رسول وليس نبيا، وموقفهم من الاستدلال بالآية السابقة هو أن
(مجرد الفصل لا يدل على اختلاف الجنسين، ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره من
الأنبياء، ثم لا يدل على أن نبينا ليس من الأنبياء، وكذلك فإنه تعالى فصل بين
الفاكهة وبين النخل والرمان ولم يدل على أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة كذلك
ههنا)([56]).
حقيقة النبوة
يرى المعتزلة
على لسان القاضي عبد الجبار بأن النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل، فالله مخير
في بعثه من يشاء من عباده، وأن صفات النبي وكذا المعجزات هي من قبل الله تعالى([57]).
وعلى هذا، فإن النبوة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها، وليست اكتسابا
من قبل العبد.
وقد بين لنا
نشوان الحميري حقيقة النبوة عند المعتزلة، حيث عقد فصلا مستقلا بعنوان: (اختلاف
الناس في النبوة)، عرض فيه الأقوال والآراء من بينها رأي مؤسس المذهب الاعتزالي
وهو واصل بن عطاء، فقال: "إن الناس
قد اختلفوا في النبوة هل هي مخصوصة أم مكتسبة؟، فقال أصحاب التناسخ([58])، منهم أبو
خالد الهمداني، وأبو خالد الأعمى المشعبذ، ومن قال بقولهم: إن النبوة مكتسبة
بالطاعة، واستدلوا على ذلك بقولهم: لولم تكن النبوة من طريق المثوبة على اكتساب
الطاعة لكانت جبرا وضرورة، ولو كانت جبرا لكانت الأنبياء غير ممتنعة منها، ولا كان
من الأنبياء ثواب على فعل الله فيهم، فصح أنها مكتسبة بالطاعة. وقال حسين النجار
ومن قال بقوله، والمريسي من المرجئة، وهشام بن الحكم، ومن قال بقولهم: إن النبوة
خصوصية من الله عز وجل وتفضل على من تفضل عليه قسرا وجبرا، وإن الله يثبت النبوة
على الأنبياء تفضلا كما تفضل بها عليهم ويثبتهم على الطاعة دون النبوة جزاء. وقال
واصل بن عطاء ومن قال بقوله: النبوة أمانة قلدها الله تعالى من كان في علمه الوفاء
بها، والقبول لها، والثبات عليها، من غير جبر لقوله تعالى: )اللّهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ( -الأنعام:
124. أي لم يجعلها الله تعالى إلا في من علم منه الوفاء بها، والقبول لها، وثواب
الأنبياء على قبولهم، وتأديتهم الرسالة، لا على فعل الله تعالى فيهم، وتعريضهم،
وقال بهذا أبو الهذيل، وبشر بن المعتمر، والنظام، وسائر العدلية([59]).
والعدلية اسم آخر للمعتزلة لقولهم بعدل الله وحكمته([60]).
ويظهر
من نقد واصل بن عطاء لأصحاب التناسخ أن النبوة حقيقتها أمانة يقلدها من كان أهلا
لها من غير جبر وإكراه وإلزام، ونفي أن تكون النبوة مكتسبة بالمجاهدة والطاعة حتى
يسد الباب في وجوه المغامرين من الزنادقة بأن يدَّعوا النبوة وينشروا عقائد الزيغ.
وذهب
المعتزلة إلى أن الرسول لا يجب أن يكون أفضل من سائر الناس قبل البعثة، ولكن متى
بعث وجب أن يصير أفضل بسبب ما يحصل منه من التكفل والعزيمة وتوطيد النفس على الصبر
وتحمل المشقة فيما يحول دون أداء الرسالة([61]).
العصمة والمعجزة
ذهب
المعتزلة إلى القول بأنه لا يجوز على الأنبياء الكبائر، لا قبل البعثة ولا بعدها،
وأما الصغائر التي لا حظ لها إلا في تقليل الثواب دون التنفير، فإنها مجوزة على
الأنبياء، ولا مانع يمنع منه، لأن قلة الثواب مما لايقدح في صدق الرسل ولا في
القبول منهم([62]).
وبهذا يمنع
المعتزلة صدور الكبائر من الأنبياء قبل البعثة، ومعتمده هو "التقبيح
العقلي"، لأن صدور المعصية منهم مما يحقرهم في النفوس، وينفر الطباع عن
اتباعهم، وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من بعثة الرسل فيكون قبيحا عقلا.
وعرف المعتزلة
المعجزة بأنها: "من يعجز الغير كما أن المقدر هو من يقدر الغير، هذا في باب
اللغة. وأما في المصطلح عليه فهو الفعل الذي يدل على صدق المدعى للنبوة وشبهه بأصل
اللغة هو أن البشر يعجزون عن الإتيان بما هذا سبيله فصار كأنه أعجزهم"([63]).
وهي فعل الله تعالى([64]).
وللمعجزة -في
نظر المعتزلة- أهمية بالغة فهي عندهم دليل على صدق الرسول وأحقية دعواه، وأنها
الدليل الوحيد على صدق النبي في دعواه للنبوة. ورد هذا في كتاب (شرح الأصول
الخمسة): "إنه تعالى إذا بعث إلينا رسولا ليعرفنا المصالح، فلا بد من أن يدعى
النبوة، ويظهر عليه العلم المعجز الدال على صدقه عقيب دعواه للنبوة"([65]).
وأورد
القاضي عبد الجبار في كتابه (تثبيت دلائل النبوة) أن المعجز هو دليل على البعثة
وثبوت الشرائع، وليس وقوع البعثة دليلا على المعجز، فالأصل في ذلك أن نستدل على
البعثة بكون المعجز ناقضا للعادة([66])،
أو أنه في غير مقدور الإنسان، لأنه من فعل الله سبحانه وتعالى، والعكس
ليس صحيحا، وفي ذلك يقول في كتاب (المغني): "فصار معرفة دلالة المعجز كالأصل
لوقوع البعثة وثبوت الشرائع كما أن حصول البعثة فرع عليه"([67]).
وفي
موضع آخر يشرح لنا القاضي عبد الجبار شروط المعجزة لتصبح دالة:
الأول: المعجزة من جهة الله أو ما
يجري مجرى ذلك.
وهو
أن تكون المعجزة من جهة الله تعالى أو في الحكم كأنه من جهته جل وعز. وعند
المعتزلة أن الفعل المعجز ينقسم إلى قسمين:
- الأول: مالا يدخل جنسه تحت مقدور
القدر كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، وقلب العصا حية وما شابه ذلك.
- والثاني: ما يدخل جنسه تحت مقدور
القدر، وذلك نحو قلب المدن، ونقل الجبار إلى أشباهه.
والقرآن من
هذا القبيل، فإن جنسه وهو الصوت داخل تحت مقدور القدر، ولهذا فإنا لو خلينا وقضية
العقل، كنا نجوّز أن يكون من جهة الرسول عليه السلام أعطاه الله تعالى زيادة علم
أمكنه معه الإتيان به، فصح أن المعجز ليس من شأنه كونه من جهة الله تعالى، بل إذا
جرى في الحكم كأنه من جهته تعالى كفى([68]).
ويعني بهذا أن القرآن كمعجز يجري مجرى فعل الله تعالى، وليس فعلا لله تعالى
مباشرة. بل لا مانع لديهم لو أعطى الله تعالى نبيه قدرة خارقة من العلم يمكن معها
الإتيان بهذا القرآن، فإن هذا القرآن رغم نسبته في هذا المثال المفترض إلى النبي،
فإنه يصح أن يكون معجزا دالا في العقل على صدقه.
الثاني: وقوع المعجزة عقب ادعاء
المدّعي للنبوة.
وهو أن تكون
المعجزة واقعة عقيب دعوى المدعي للنبوة، لأنه لو تقدم الدعوى لم تتعلق به، فلا
يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره. ولذلك منع المعتزلة جواز
تقدم المعجزة على دعوى النبي، وإن كان بعض من المعتزلة جوزها كأبي القاسم البلخي.
وكذلك منع المعتزلة تأخير المعجزة على الدعوى، ويفرقون في هذه الحالة بين المعجزة
التي تقترن بالدعوى وتدل على صدقها، وبين المعجزات التي تأتي بعد ثبوت النبوة
للنبي وصدقه فيها، وبناء على هذه التفرقة، فإن المعتزلة يرون بأن أخبار النبي
المستقبلية مثل قوله لعمار رضي الله عنه: (ستقتلك الفئة الباغية، وآخر زادك ضياح
من لبن) وأشباهها، أعلام معجزة دالة ومؤكدة على صدقه رغم تأخرها على الدعوى، وذلك
لأن تصديقه كرسول ونبي قد ثبت من قبل بمعجزة أخرى غير هذه المعجزات.
الثالث: موافقة المعجزة للدعوى.
إن المعجزة لا
بد أن تكون مطابقة لدعواه، فإنه لو لم تكن كذلك، وكان بالعكس لم تكن تتعلق بدعواه،
فلا تدل المعجزة على صدقه.
الرابع: المعجزة خارقة للعادة.
وهذا الشرط
الأخير من شروط المعجزة عند المعتزلة بأن تكون المعجزة ناقضة لعادة قومه([69]).
وقرروا لنقض العادة مبدأين عامين:
- الأول: أن تظهر المعجزة أو يظهر
نقض العادة لقوم يكون ذلك نقضا لعادة لهم. وهذا ما ينص عليه القاضي عبد الجبار في
(المغني): "إن من حق نقض العادات أن يظهر فيمن العادة عادة له"([70]).
- والثاني: أن ذلك لا يتم إلا بأن
تكون العادة مستمرة فيهم أصلا من الله عز وجل، فتصبح معروفة بالضرورة لهم. وفي ذلك
يقول القاضي عبد الجبار في نفس الكتاب السابق: "لابد إذا أراد الله تعالى أن
يقيم الحجة من جهة الرسول أن يقدم قبل ذلك العادات ويجعلها مستمرة، ويقرر في
النفوس معرفة حالها حتى إذا ظهر المعجز الذي ينقض العادة يكون قد أزاح العلة وأقام
الحجة"([71]).
وقال القاضي
عبد الجبار في كتاب (المغني) مبينا شروط المعجزة: "فكان عليهم أن يخرجوا كون
الكرامة ناقضة للعادة على جهة تصديق الله لهم كأنبياء. وأن تكون مثلا في مقدور
غيره من الصالحين أو البشر، وهذا عكس المعجزة التي وإن كانت من جنس مقدور المكلف،
إلا أنه يعجز عن الإتيان بمثلها، لأنها تقع بقدر أعظم من القدر العادية للمكلفين([72]).
واضح
من هذا النص أن الشرط الأساسي للمعجزة لحصول العلم واليقين أن تكون ناقضة للعادة.
ولذلك يقرر القاضي أنه: "إذا فكر العالم وعلم أن ما يتعلق بالعادة طريقه
الظنون، وما يتعلق بنقض العادة طريقه العلم واليقين، فبأن يتمسك ويزيل عن نفسه
الشبه فيه أولى سيما ومصالح الدنيا موضوعة لأن تكون إعتبارا في مصالح الدين"([73]).
وفيما
يتعلق بنبوة محمدe، فإن المعجزات
الدالة على نبوته كثيرة، ويُعد القرآن الكريم من أهم وأكبر المعجزات، وهذا محل
اتفاق العلماء جميعا -من كل المذاهب العقائدية والفقهية سنة وشيعة- ولكن الغريب أن
بعض المعتزلة لهم رأي شاذ في هذا الصدد وهم القائلون بالصرفة كالنظام حيث إنه أنكر
أن يكون القرآن معجزة([74])،
وقال المردارية([75]) من
المعتزلة: إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة([76]).
وذهب إلى هذا أيضا المعتزلة الآخرون من أمثال: عباد بن سليمان وهشام الفوطي.
إذن فهم لا
يرون في نظم القرآن وتأليفه إعجازا ذاتيا، فبإمكان للبلغاء والفصحاء أن يأتوا
بمثله لولا أن الله تعالى صرفهم عن ذلك.
ومن هنا ذهب
أكثر المعتزلة إلى تكفير النظام والمردار وغيرهم القائلون بعدم اعتبار القرآن
معجزة على نبوة النبي، وممن قال بتكفيرهم من شيوخ المعتزلة أبو الهذيل والجبائي
والأسكافي وجعفر بن حرب([77]).
ولتقييم هذه الآراء الشاذة داخل المعتزلة فقام القاضي عبد الجبار بمهمة الرد على
هؤلاء، إذ نقد مذهب الصرفة في أكثر من موضع في كتابه المشهور (المغني) و(تنزيه
القرآن عن المطاعن) ([78]).
وأورد القاضي
عبد الجبار عددا من المعجزات الحسية للنبي كـ: مجيء الشجرة وعودها إلى مكانها.
وسقي الكثير من الماء القليل في بعض الغزوات. وحنين الجذع، وتسبيح الحصى، وكلام
الذئب، وانشقاق القمر، وكذلك الإخبار بالمغيبات التي حدثت فيما بعد مثله قوله
لعمار السابق ذكره. وهذه المعجزات متواترة لأنها وقعت عند الجمع العظيم وحصل النقل
على هذا الحد([79]).
وهناك
نقطة مهمة في هذه المسألة لاختلاف المعتزلة مع غيرهم من الفرق الكلامية وهي
إنكارهم ظهور المعجزات والكرامة للأولياء والصالحين، لأنه لا يجوز أن يظهر
على هذا الحد إلا ويدل على النبوة([80]).
ويستدل على ذلك بأنه لو كانت تظهر عليهم: "لكانت بأن تظهر على السلف الصالح
من كبار الصحابة أولى بأن تظهر على غيرهم ممن نشك في حالهم"([81]).
ومن
هنا يرفض المعتزلة كرامات الصوفية، وذلك أن النبي e هو الأجدر بالمعجزات والكرامات وليس
الولي الصوفي، وبخاصة أن المعجزة صفة إلهية وهي نقض للعادة يتعذر على أي إنسان أن
يفعل مماثلا له.
وقد
صرح القاضي عبد الجبار إنكار الكرامات للأولياء والصالحين والصادقين سائلا:
"فإن قال: أفيجوز ظهور المعجزات على غير الأنبياء على ما يقوله كثير من
العوام، أنها تظهر كرامة على الصالحين، وكما يقول بعضهم أنها تظهر على الصادقين؟.
قيل له: لا يجوز ذلك، لأنها تدل على التفرقة بين النبي ومن ليس بنبي، لأن الرسول
يقول لغيره: أنا، وإن كنت بشرا مثلكم، فكما كان المعجز يلزمكم الانقياد لي وطاعتي،
فلا بد أن يختص بذلك ليصح هذا المعنى، فلهذا لا يجوز ظهوره على غير الأنبياء ...
فإن قال: فقد روي عن كثير من الصالحين أن المعجز ظهر عليهم. قيل له: هذه أخبار لا
نصدق بها، لأنهم ربما خبروا عن من ينكر ذلك لنفسه، وربما خبروا بالمحال من هذا
الباب، نحو اخبارهم عن بعضهم أنه وجد في وقت واحد في بلدين، إلى غير ذلك مما
تنافيه العقول([82]).
وهذا النص
واضح أن المعجزات عند المعتزلة خاصة بالأنبياء فقط، فلا يصح ظهورها على غير النبي
كائنا من كان هذا الغير، من إمام، أو ولي، أو صالح، أو صادق، وعندهم أن القول
بجواز ظهور المعجزات على أيدي هؤلاء لا يختلف عن القول بجواز ظهور المعجزات على
أيدي السحرة والكهنة والكذابين، وكل ذلك قبيح يتنزه الله عن فعله([83]).
لأن ظهور المعجزة على غير يد النبي e سوف يذهب تماما بكل الفروق بين الأنبياء
وغيرهم، وبناء على ذلك لا نجد لكرامات الأولياء مكانا في فلسفة المعتزلة، وهي
كرامات أجمع عليها جمهور المسلمين([84]).
ويرجع صاحب
(الفرق بين الفرق) رفض المعتزلة للكرامة لأنهم في رأيه: "لم يجدوا في أهل
بدعتهم ذا كرامة، فأنكروا ما حرموه بشؤم بدعتهم، وظنوا أن إجازة ظهور الكرامة
للأولياء يقدح في دلالة المعجزة على النبوة"([85]).
ويبدو
أن السبب الذي أدى بالمعتزلة إلى رفض كرامة الأولياء والصالحين هو خوفهم الشديد
على معجزة الرسل من النقض، فحاولوا بقدر الإمكان والطاقة أن يبعدوا أية شبهة يمكن
أن تلحق بدلالة المعجزة ليختص بها النبي e وحده دون غيره.
وفي رأينا أن
أنكار المعتزلة للكرامة بحجة أن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي باطل، وذلك لأن
الكرامة قد ثبتت بالشرع والمشاهد، وأما قضية الاشتباه فغير صحيح لبعده عن الواقع،
إضافة إلى أن النبي e آخر الأنبياء فلا ينافسه أحد بعده بالمعجزات
النبوية.
المبحث الثالث
النبوة عند الأشعرية
حكم بعثة الرسل
ذهب المذهب
الأشعري كغيره من المذاهب الكلامية إلى أن إثبات النبوات من أعظم أركان الدين([86])،
وقالوا -خلافا للمعتزلة- إن النبوة ممكنة أي بإمكان إرسال الرسل من الله عقلا،
بمعنى أنها ليست مستحيلة على الله تعالى([87])،
كما أنها ليست واجبة على الله عز وجل[88])،
ذلك لأن الإيجاب ينافي حرية الإرادة الإلهية، لذا فهي ممكنة([89])،
وقد صرح بهذا القول الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل): "وانبعاث الرسل من
القضايا الجائزة لا الواجبة ولا المستحيلة"([90])،
وفي موضع آخر من كتابه (نهاية الإقدام) يستعرض بعض آراء العلماء في البعثة قائلا:
"صارت البراهمة والصابئة إلى القول باستحالة النبوات عقلا. وصارت المعتزلة
وجماعة من االشيعة إلى القول بوجوب وجود النبوات عقلا من جهة اللطف، وصارت
الأشعرية وجماعة من أهل السنة إلى القول بجوزا وجود النبوات عقلا ووقوعها في
الوجود عيانا، وتنتفي استحالتها بتحقيق وجودها كما ثبت تصورها بنفي
استحالتها"([91]).
ونفس الحديث عن رأي البراهمية نقل الجويني بأنهم أنكروا النبوات وجحدوها عقلا، وأحالوا
ابتعاث بشر رسولا([92]).
إذن، فموقف
الأشعرية هنا لا وجوب عليه ولا استحالة عليه في ذلك. وقالوا إن النبوة يتوقف عليها
صلاح البشر، وأن الله تعالى قد قرر بأن العذاب متوقف على بعثة الرسل، قوله تعالى: )مَنِ اهْتَدَى
فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
رَسُولاً( -الإسراء: 15-. وفي ذلك يقول الإيجي: "فالنبوة رحمة
وموهبة متعلقة بمشيئته فقط، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا هو الذي ذهب إليه أهل
الحق([93]) بناء
على القول بالقادر المختار([94]).
وقريب من هذه العبارة يقول التفتازاني: "إن البعثة لطف ورحمة من الله يحسن
فعلها، ولا يقبح تركها"([95]).
والحقيقة أن
هذا الموقف -أي القول بإمكان البعثة وأنها لا مستحيلا ولا وجوبا- في حد ذاتها لا
يحل القضية، ذلك لأن ظاهر القرآن )وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً( -الإسراء:
15-. يفيد أن إرسال الرسل مسألة لم تتخلف في كل أمة، وأن تحرجهم من القول بالوجوب
لم يحل الإشكال، إذا كان ما يفيده القرآن هو ضرورة الرسالة([96]).
أي وجوب البعثة.
الفرق بين النبي والرسول
يرى المذهب
الأشعري التفرقة بين النبي والرسول، حيث يحكي ابن فورك أن الإمام الأشعري:
"كان يفرق بين النبي والرسول، ويقول: إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ...
وكان يقول: إن الرسول هو من يرسل إلى الخلق، ويوجب عليه تبليغ الرسالات، ويؤمر
الخلق بطاعته واتباع أمره. وقد يكون نبيا ولا يكون قدر أرسل، ولا أمر بأداء
الرسالة، وذلك بإبانة حاله من غيره بكرامات يخص بها حتى ترتفع منزلته بذلك وتشرف([97]).
وهذا ما أكد عليه البغدادي في كتابه (أصول الدين) فيرى أن كل رسول الله عز وجل نبي
وليس كل نبي رسولا له. والفرق بينهما أن النبي e من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه
الملك بالوحي. والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ بعض أحكام شريعة قبله([98]).
وبهذا أن
الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فإنسان أوحي إليه بشرع
ولم يؤمر بتبليغه. وكل من النبي والرسول يوحى إليه، بالإضافة إلى أن النبي قد يبعث
في قوم مؤمنين بشرائع سابقة، كأنبياء بني إسرائيل، يأمرون بشريعة التوراة، وقد
يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة. وأما الرسول فإنهم يأتون بشريعة جديدة، حيث
يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى مخالفين
فيكذبهم بعضهم.
حقيقة النبوة
يرى
الأشاعرة أن النبوة هبة من الله عز وجل، أكرم بها الله أنبياءه هي هي بمحض الفضل
الإلهي، ولا يمكن لأحد من البشر أن ينالها مهما الجهد المبذول في الطاعة والعبادة
والرياضة النفسية، ولا علاقة لها بالاستعداد الفطري، وإنما هي هبة من الله تعالى.
وفي ذلك يقول الشهرستاني: "إن النبوة ليست صفة راجعة إلى النبي، ولا درجة
يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبه، ولا استعدادا نفسيا يستحق به الاتصال بالروحانيات، بل
رحمة يمن الله بها على من يشاء من عباده"([99]).
ويستدل على ذلك بأدلة قرآنية منها قوله تعالى: وقوله تعالى: )وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ( -الأنبياء:
107-. والأنبياء خيرة الله في خلقه، وحجة الله على عباده، والوسائل إليه، وأبواب
رحمته، وأسباب نعمته: )اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ( -الحج: 75-. فكما يصطفيهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة،
يصطفيهم من الخلق فعلا بكمال الفطرة، ونقاء الجوهر، وصفاء العنصر، وطيب الأخلاق،
وكرم الأعراق، فيرقيهم مرتبة مرتبة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، وكملت قوته
النفسانية وتهيأت لقبول الأسرار الإلهية، بعث إليهم ملكا وأنزل عليهم كتابا([100]).
واضح من هذا
النص نفي كون النبوة اكتسابا بأي وجه من الوجوه لا بالعبادة ولا بالطاعة. ومن
ثم فهي خاصة فيمن اصطفاه الله لها، وأن اختياره للنبي لا يقع على النبي حال
بعثته ووقت تكليفه بالرسالة فقط، وإنما الاصطفاء يكون سابقا للبعثة ويخص الله به
نبيه حتى قبل ميلاد هذا النبي الكريم.
وفي موضع آخر
يقرر الإيجي في كتابه (المواقف) بعدم الحاجة إلى الاستعداد النفسي للنبوة قائلا:
"ولا يشترط فيه شرط ولا استعداد بل الله يختص برحمته من يشاء من عباده"([101]).
العصمة والمعجزة
يرى علماء الأشاعرة بأن الأنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر، يقول البغدادي:
"أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومون بعد النبوة عن الذنوب كلها،
وأما السهو والخطأ فليسا من الذنوب، فذلك ساغا عليهم، وقد سهى نبينا e في
صلاته ... وأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة ... وإنما تصح عصمتهم على أصولنا، إذا
قلنا: إن الله عز وجل أقدرهم على الطاعة دون المعاصي، فصاروا بذلك معصومين عن
المعاصي"([102]). وذكر الإيجي
بأن الإمام الأشعري وكثير من الأئمة منعوا صدور السهو والنسيان على الأنبياء
لدلالة المعجزة على صدقهم، لكن البعض منهم جوزوا السهو على الرسل، لكن ليس في
المسائل البلاغية([103]).
ويلاحظ ابن
تيمية أن جمهور الأشاعرة يقولون بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر([104]).
وعصمة
الأنبياء ثابتة بوجوه عدّة بينها الرازي:
- الأول: أن كل من كانت نعمة الله
تعالى عليه أكثر، كان صدور الذنب منه أقبح وأفحش، ونعمة الله تعالى على الأنبياء
أكثر فوجب أن تكون ذنوبهم أقبح وأفحش من ذنوب كل الأمة، وأن يستحقوا من الزجر
والتوبيخ فوق ما يستحقه جمبع عصاة الأمة، وهذا باطل، فذاك باطل.
- الثاني: أنه لو صدر الذنب منه لكان
فاسقا، ولو كان فاسقا لوجب أن لا تقبل شهادته، لقوله تعالى:
)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( -الحجرات، 6-. وإذا لم تقبل شهادته في هذه
الأشياء الحقيرة، فبأن لا تقبل في إثبات الأديان الباقية إلى يوم القيامة، كان
أولى، وهذا باطل فذاك باطل.
- الثالث: أنه
تعالى قال في حق محمد e "فاتبعوه لعلكم تفلحون"، وقال تعالى: )قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( -آل عمران، 31-. فلو أتى بالمعصية لوجب علينا بحكم هذه النصوص متابعته
في فعل ذلك الذنب، وهذا باطل فذلك باطل([105]).
ويعرف البغدادي المعجزة قائلا: "المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي
هو نقيض القدرة. والمعجز في الحقيقة فاعل المعجز في غيره، وهو الله تعالى، كما أنه
هو المُقدِر، لأنه فاعل القدرة في غيره. وإنما قيل لأعلام الرسل السلام معجزات
لظهور المرسل إليهم عن معارضتهم بأمثالها"([106]). وهي عبارة
شائعة على التوسع والاستعارة والتجوز، فإن المعجز على التحقيق خالق العجز، والذين
يتعلق التحدى يهم لا يعجزون عن معارضة النبي e. فإن المعجزة إن كانت خارجة من قبيل مقدورات
البشر، فلا يتصور أيضا عجز المتحدين بالمعجزات، فإن العجز يقارن المعجوز عنه. فلو
عجزوا عن معارضة، لوجدت المعارضة ضرورة ... فالمعنى بالإعجاز الإنباء عن امتناع
المعارضة من غير تعرض لوجود العجز الذي هو ضد القدرة([107]).
ويلاحظ أن الأشاعرة يوافقون المعتزلة بأن المعجزة هي الدليل الوحيد على ثبوت
النبوة، وإن اختلفوا معهم في كيفية دلالتها على صدق النبيe، حيث أوضح
الجويني دور المعجزة في إثبات النبوة قائلا: "النبي لابد له من إظهار
معجزة تدل على صدقه، فإذا أتى بها، وبان لقومه وجه الاعجاز فيها، لزمهم تصديقه
وطاعته، ولم يكن لهم مطالبته بمعجزة أخرى، فإن طالبوه بأخرى، فإن شاء الله عز وجل
أظهر الأخرى توكيدا للحجة عليهم، وإن شاء عاقبهم على ترك الإيمان بمن قد دلت
المعجزة على صدقه. والمعجزة الواحدة كافية في الدلالة على صدقه، ومن لم يؤمن به
بعدها استحق العقاب([108]).
وهذا الرأي مخالف لرأي جمهور أهل السنة بأن دلائل ثبوت النبوة للأنبياء
كثيرة ومنها المعجزات.
وللمعجزة
ستة شروط أوردها البغدادي في كتابه (أصول الدين) فهي:
- أولا: أن تكون
من فعل الله عز وجل أو ما يجري مجرى فعله، وإن لم يكن في نفسه فعلا.
- ثانيا: أن
يكون ناقضا للعادة قيمن هو معجز له وحجة عليه.
- ثالثا: أن
يتعذر على المتحدي به فعل مثله في الجنس أو على الوجه الذي وقع التحدي عليه.
- رابعا: أن
يكون مطابقا لدعوى من ظهرت عليه على وجه التصديق، فأما إن شهدت بتكذيبه فهي خارجة
من هذا الباب.
- خامسا: أن لا
يتأخر عن دعواه تأخرا يعلم أنه لا يتعلق بها.
وقد شرح
الجويني هذه الشروط وفصلها بالتمثيل قائلا: "إن المعجزة لها أوصاف تتعين
الإحاطة بها. منها أن تكون فعلا لله تعالى، فلا يجوز أن تكون المعجزة صفة قديمة،
إذ لا اختصاص للصفة القديمة ببعض المتحدين دون بعض. ولو كانت الصفة القديمة معجزة،
لكان وجود الباري تعالى معجزا. وإنما المعجز فعل من أفعال الله تعالى نازل منزلة
قوله لمدّعي النبوة: صدقت ... أن تكون خارقة للعادة، إذ لو كانت عامة معتادة يستوي
فيها البار والفاجر، والصالح والطالح، ومدعي النبوة المحق بها والمفترى بدعواه،
لما أفاد ما يقدر معجزا تمييزا وتنصيصا على الصادق، ولا خفاء بذلك فنطنب فيه ...
أن تتعلق بتصديق دعوى من ظهرت على يديه، وهذه الشروط تنقسم إلى أوجه لا بد من
الإحاطة بها. منها أن يتحدى النبي بالمعجزة، وتظهر على وفق دعواه، فلو ظهرت آية من
شخص وهو ساكت صامت فلا تكون الآية معجزة ... ثم يكفي في التحدي أن يقول: آية صدقي
أن يحيى الله هذا الميت، وليس من شرط المتحدي أن يقول: هذه آيتي ولا يأتي أحد
بمثلها، فإن الغرض من التحدي ربط الدعوة بالمعجزة ... ومن وجوهه أن لا تتقدم
المعجزة على الدعوى، فلو ظهرت آية أو لا وانقضت، فقال قائل: أنا نبي والذي مضى
كانت معجزتي، فلا يكترث به، إذ لا تعلق لما انقضى بدعواه ... ومن وجوه تعلق
المعجزة بالتصديق، أن لا تظهر مكذبة للنبي، مثل أن يدَّعي مدّعِي النبوة، فيقول:
آية صدقي أن ينطق الله يدى، فإذا أنطقها الله تعالى بتكذيبه، وقالت: اعلموا أن هذ
مفتر فاحذروه، فلا يكون ذلك آية. ولو قال: آيتي أن يحيى الله هذا الميت، فأحياه
الله تعالى، فقام وله لسان زلق، فقال: صاحبكم هذ متخرص، وقد بعثني الله تعالى
لأفضحه ثم خر صعقا ... أن التكذيب إن كان خارقا للعادة فهو الذي يقدح في المعجزة،
وذلك بمثابة نطق اليد بالتكذيب. فأما الميت إذا حيي وكذب فتكذيبه ليس بخارق
للعادة. وللنبي أن يقول: إنما الآية إحياؤه وتكذيبه إياي كتكذيب سائر الكفر"([110]).
وقد تحدث
الشهرستاني عن إعجاز القرآن بأنه معجز في ألفاظه من حيث الفصاحة والجزالة والنظم
والبلاغة، فهو معجز في فصاحته من حيث أن الفصاحة هي دلالة اللفظ على المعنى بشرط
إيضاح وجه المعنى والغرض منه، وأنه لمعجز في جزالته من حيث أن الجزالة هي دلالة
اللفظ على ا لمعنى بشرط قلة الحروف، واختصارها، وتناسب مخارجها، وتجتمع الجزالة
والفصاحة معا في آيات كثيرة من القرآن، حيث يجمع معان كثيرة في ألفاظ يسيرة مثل
قوله تعالى: )وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( -البقرة: 179-. وهو معجز في نظمه الذي هو ترتيب الأقوال بعضها
على بعض، ويتعدد الحسن فيه بقدر تناسب الكلمات في أوزانها وتقاربها في الدلالة على
المعنى، وذلك أنواع وأصناف([111]).
ويستعرض
الأشعرية المعجزات النبوية منها أفعال الله تعالى لا يقدر على جنسها غيره، وهي على
سبيل المثال: إحياء الأموات، وإبراء الأكمه والأبرص، وقلب العصا حية، وفلق البحر،
وإمساك الماء في الهواء، وتشقيق القمر، وإنطاق الحصى، وإخراج الماء من بين الأصابع
ونحو ذلك. ومنها ما هو خلق لله اختراعا، وكسب لصاحب المعجزة، كإقداره إنسانا على
الطفر-أي القفز- إلى السماء وعلى قطع المسافة البعدية في الساعة القصيرة، وعلى
إطلاق لسان الأعجمي بالعربية ونحو ذلك مما لم يجر العادة به([112]).
وثمة أمر آخر
يجدر بالذكر هنا وهو موقف الأشعرية من العصمة النبوية، فيبين لنا البغدادي اتفاق
جميع الأشعرية القول بوجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب كلها، وأما
السهو والخطأ فليسا من الذنوب، فلذلك ساغا عليهم، وقد سهى نبينا e في صلاته
... وأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة، وإنما تصح عصمتهم على أصولنا، إذا قلنا: إن
الله عز وجل أقدرهم على الطاعة دون المعاصي، فصاروا بذلك معصومين عن المعاصي([113]).
وفيما يتعلق بالكرامات
لأولياء الله الصالحين فيرى الأشعرية ثبوتها لأنها أمر خارق للعادة غير مقرون
بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها يظهر على يد عبد صالح ملتزم بالشريعة الإسلامية،
وقد كتب الجويني فصلا خاصا "في إثبات الكرامات وتمييزها من المعجزات"،
فبين فيه أن الحق جوز انخراق العادات أي الكرامة في حق الأولياء، والأدلة على ذلك
كثيرة، كأصحاب الكهف وما جرى لهم من الآيات، لا سبيل إلى جحده، وما كانوا أنبياء
إجماعا. وكذلك بضروب من الآيات، فكان زكريا يصادف عندها فاكهة الشتاء في الصيف،
وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقول معجبا: "أنى لك هذا" كما هو مبين في
القرآن: )فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً
حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ( -آل
عمران: 37-. وتساقط عليها الرطب الجني، إلى غير ذلك من آياتها. وكذلك أم موسى عليه
السلام، ألهمت في أمره بما لا خفاء به. وجرى من الآيات في مولد الرسول عليه السلام
ما لاينكره منتم إلى الإسلام، وكان ذلك قبل النبوة، والانبعاث والمعجزة لا تسبق
دعوى النبوة. وناقش الجويني المنكرين للكرامات قولهم بأنه لو جاز انخراق العادة من
وجه، لجاز ذلك من كل وجه ثم يجر مقاد ذلك إلى ظهور ما كان معجزة لنبي على يد ولي،
وذل يفضي إلى تكذيب النبي المتحدث بآيته، القائل لمن تحداه: لا يأتي أحد بمثل ما
أتيت به. فلو جاز إتيان الولي بمثله، لتضمن ذلك نسبة الأنبياء إلى الافتراء. فرد
الجويني قائلا: "وهذا تمويق لا تحصيل له، إذ لا خلاف في أن الشيء الواحد من
خوارق العوائد يجوز أن يكون معجزة لنبي بعد نبي، ثم لا يكون ظهوره ثانيا مكذِّبا
لمن تحدّى به أولا. فإن قالوا: النبي يقيد دعواه في خطاب من تحداه، ويقول: لا يأتي
أحد بمثل ذلك إلا من يدعي النبوة صادقا في دعواه. قلنا: إن ساغ تقييد الدعوى بما
ذكرتموه، فلا يمتنع أيضا أن يقول النبي: لا يأتي بمثل ذلك متنبئ ولا ممخرق مفتر،
ولا من يروم تكذيبي، وتخرج الكرامات عن هذه الجهات، وليس تقييد أولى من تقييد ...
فإن قيل فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل، إلا
بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة"([114]).
وقد فصل
البغدادي الحديث عن التفرقة بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، حيث ذكر في
المسألة الخامسة من كتابه (أصول الدين) بأن المعجزات والكرامات متساوية في كونها
ناقضة للعادات، غير أن الفرق بينهما من وجهين:
- أولا: تسمية
ما يدل على صدق الأنبياء معجزة وتسمية ما يظهر على الأولياء كرامة للتمييز بينهما.
- ثانيا: إن
صاحب المعجزة لا يكتم معجزته، بل يظهرها ويتحدّى بها خصومه، ويقول: إن لم تصدقوني
فعارضوني بمثلها. وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها ولا يدّعي فيها، فإن أطلع الله
عليها بعض عباده كان ذلك تنبيها لما أطلعه الله تعالى عليها على حسن منزلة صاحب
الكرامة عنده، أو على صدق دعواه فيما يدّعيه من الحال.
ثم ذكر وجها
إضافيا وهو أن صاحب المعجزة مأمون التبديل معصوم عن الكفر والمعصية بعد ظهور
المعجزة عليه، وصاحب الكرامة لا يؤمن تبدل حاله([115]).
وثمة أمر آخر
يجدر بالحديث هنا عن موقف علماء الكلام من نبوة النساء، حيث اختلفوا في هذه
المسألة إلى قولين، فذهب البعض إلى إثبات النبوة للنساء. فمن هؤلاء الأشعري، وابن
حزم، والقرطبي([116]).
وحصيلة القول فإنهم متفقون على بعض النساء كمريم، ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها
ويعدّون من النساء النبيات: حواء وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية. فقال
القرطبي في تفسير الآيات السابقة: "هذا رد على القائلين: )وَقَالُواْ
لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ( -الأنعام: 8-. أي: أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة ولا جني ولا
ملك، وهذا يرد ما يروي عن النبي e أنه قال: (إن في النساء أربع نبيات حواء، وآسية، وأم موسى،
ومريم)([117]).
وقال القرطبي في إثبات النبوة لمريم: "واختلف الناس في نبوة مريم، فقيل: كانت
نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك، وقيل: لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر،
ورؤيتها للملك كما رئي جبريل في صفة دحية، حين سؤاله عن الإيمان والإسلام، والأول
أظهر)([118]).
وفي قوله
تعالى: )وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ
وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ( -آل
عمران: 42-. قال: روي مسل عن أبي موسى قال: قال رسول الله e: (كمل من
الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ...)([119]).
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: "الكمال هو التناهي، والتمام، والكمال المطلق
إنما هو الله -تعالى- خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء، ثم يليهم
الأولياء من الصديقين والشهدء والصالحين. وإذا تقرر هذا، فقد قيل: إن الكمال
المذكور في الحديث يعني به النبوة، فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسية
نبيتين، وقد قيل بذلك. والصحيح: أن مريم نبية، لأن الله -تعالى- أوحى إليها بواسطة
الملك، كما أوحى إلى سائر النبيين. وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة
واضحة، بل على صدّيقيتها وفضلها ... فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من
جميع نساء العالم من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، فإن الملائكة قد
بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار، والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء،
فهي إذن نبية ... ([120]).
ولم يفضل الله
تعالى على مريم من النساء غيرها، وذلك أن روح القدس كلمها، وظهر لها ونفخ في
درعها، ودنا منها للنفخة، فليس هذا لأحد من النساء. وصدقت بكلمات ربها ولم تسأل
آية عندما بشرت -كما سأل زكريا من الآية- ولذلك سماها الله في تنزيله (صديقة): )فَقَالَ
وَأُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ( -المائدة: 75-. وقال: )وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ( -التحريم:
12-. ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة، جاء في الخبر عنه e: (لو أقسمت
لبررت، لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضع عشرة رجلا، منهم: إبراهيم، وإسماعيل،
وإسحاق، ويعقوب، والأسباط، وموسى، وعيسى، ومريم ابنة عمران ([121]).
وذهب
الجمهور إلى نفي النبوة للنساء -الماتريدي، النووي، الجويني- لصريح الآيات
القرآنية بأن الرسل من الرجال دون النساء، وإليه ذهب جمهور العلماء([122]).
ويدل على هذا قوله تعالى: )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم
مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى( -يوسف: 109-. وقوله تعالى: )وَمَا
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ ( -النحل:43-.
فتدل هذه الآيات القرآنية على أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا من النساء ولا
من الجن.
وأرى الصحيح
ما ذهب إليه الجمهور لصريح ما دلت عليه الآية السابق ذكرها، ولأن الرسالة تقتضي
الاشتهار بالدعوة، والأنثى تقتضي التستر، وتنافي الاشتهار، لما بين الاشتهار
والاستتار من التمانع([123]).
ولا يخفى أن الذكورة أكمل من الأنوثة، جعل الله القوامة للرجال على النساء في قوله
تعالى: )الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ( -النساء:
34-. وخبر الرسول أن النساء ناقصات عقل ودين([124]).
المبحث الرابع
النبوة عند الماتريدية
حكم بعثة الرسل
انضم
المذهب الماتريدي إلى رأي الأشعرية القائلون بأن بعثة الرسل ممكن عقلا، وليس
مستحيلا أو ممتنعا كما عليه البراهمة والصائبة، ولا وجوبا كما عليه المعتزلة
والفلاسفة. وكون إمكان البعثة من الله عقلا، فلأنه من الأمور الممكنة، وكل ممكن
يجوز في حقه عز وجل فعله أو تركه. فالله قادر وفاعل مختار فله أن يتصرف في ملكه
وعباده بالأمر والنهي، وله أن يختار قوما منهم لتعريف الإسلام وما جاء به من أمر
ونهي. وقد أورد التفتازاني هذا الكلام في كتابه (شرح المقاصد) قائلا:
"المنكرون للنبوة منهم من قال باستحالتها، ولا اعتداد بهم، ومن من قال بعد
الاحتياج إليها كالبراهمة –جمع من الهند أصحاب برهام-، ومنهم من لزم ذلك من
عقائدهم كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات"([125]).
وأكد علماء
الماتريدية إمكان البعث، فقال التفتازاني بأنها: "لطف ورحمة من الله يحسن
فعلها ولا يقبح تركها"([126]).
وقال البياضي موضحا كذلك إمكان البعثة: "والمختار أنها -أي النبوة- لطف من
الله ورحمة يحسن فعلها، ولا يقبح تركها، ولا يتبنى على استحقاق من المبعوث واجتماع
شروط فيه، كما زعمه الفلاسفة، بل الله تعالى يختص برحمته من يشاء، وهو أعلم حيث
يجعل رسالاته"([127]).
ويفهم
من هذا النص أن الله قادر مختار بمعنى أنه إذا شاء أن يفعل شيئا فعله، وإن شاء أن
يترك شيئا تركه.
وأشار
البيضاوي إلى الدور الأساسي ومهمة النبوة وحاجة البشرية إليها قائلا: "إحتياج
إلى النبي، لما لم يكن بحيث يستقل بأمر نفسه، وكان أمر معاشه لايتم إلا بمشاركة
آخر من أبناء جنسه، ومعاونة، ومعاونة، ومعارضة يجريان بينهما فيما يعن لهما بما
يتوقف عليه صلاح الشخص أو النوع، احتاج إلى عدل يحفظه بشرع يفرضه شارع يختص بآيات
ظاهرة ومعجزات باهرة، ويدعو إلى طاعته ويحث على إجابته ويصدق في مقالته، يوعد
المسئ بالعقاب ويعد المطيع بالثواب وهو النبي"([128]).
وفي
موضع آخر ناقش الماتريدية رأي المنكرين للنبوة في عدة شبهاتهم تحدث عنها
التفتازاني:
- الشبهة
الأولى: إن البعثة تتوقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله تعالى، ولا سبيل إلى
ذلك ... وأجاب بأن: "المنع لجواز أن ينصب دليلا له أو يخلق علما ضروريا
فيه".
- الشبهة
الثانية: وهي للبراهمة أن ما جاء به النبي إما أن يكون موافقا للعقل حسنا عنده،
فيقبل ويفعل، وإن لم يكن نبيا أو مخالفا له قبيحا عنده فيرد ويترك، وإن جاء به
النبي، وأيا ما كان لا حاجة إليه، فإن قيل: لعله لا يكون حسنا عند العقل، ولا
قبيحا، قلنا: فيفعل عند الحاجة، لأن مجرد الاحتمال لا يعارض تنجز الاحتياج، ويترك
عند عدمها للاحتياط ... وأجاب بأن: "ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته فيعاضده
النبي ويؤكده. بمنزلة الأدلة العقلية على مدلول واحد. وقد لا يستقل، فيدله عليه
ويرشده".
- الشبهة
الثالثة: إن العمدة في باب البعثة هي التكليف، وهو عبث لا يليق بالحكيم، إذ لا
يشمل على فائدة للعبد لكونه في حقه مضرة ناجزة ومشقة ظاهرة، ولا للمعبود لتعاليه
عن الاستفادة والانتفاع ... وأجاب بأن: "مضاره الناجزة قليلة جد بالنسبة إلى
منافعها الدنيوية والأخروية الظاهرة لدى الواقفين على ظواهر شريعة النبوة، فضلا عن
الكاشفين عن أسرارها الخفية".
- الشبهة
الرابعة: وهي لأهل الخلاعة المنهمكين في اتباع الهوى، وترك الطاعة أنا نجد الشرائع
مشملة على أفعال وهيئات لا يشك في أن الصانع الحكيم لا يعتبرها ولا يأمر بها كما
نشاهد في الحج والصلاة ... وأجاب بأنها: "أمور تعبدية اعتبرها الشارع ابتلاء
للمكلفين، وتطويعا لنفوسهم وتأكيدا لملكة امتثالهم الأوامر والنواهي"([129]).
وهذه المناقشة
تثبت مدى عناية علماء الماتريدية في بحث قضايا النبوات والرد على من أنكرها جملة
كالبراهمة.
الفرق بين النبي والرسول
عرف
التفتازاني النبي والرسول قائلا: "النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي
إليه، وكذا الرسول، وقد يختص بمن خص بشريعة وكتاب ... وأما الرسول فله:
"شريعة وكتاب، فيكون أخص من النبي ... فقيل: " هو من له كتاب أونسخ لبعض
أحكام الشريعة السابقة، والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشع -عليه السلام-"([130]).
وفي نفس السياق قال كمال الدين البياضي: "أنه قد يطلق النبي على الوجه العام،
أو المرادف للرسول، فالنبي إنسان بعثه الله لبتليغ ما أوحي إليه، وكذا الرسول فهو
المراد هنا، ولذا اقتصر على الأنبياء، وقد يخص الرسول بمن له شريعة وكتاب، فيكون
أخص من النبي"([131]).
ومن
هذا النص نفهم أن الماتريدية لم يفرِّقوا في أمر التبليغ بين النبي والرسول، حيث
يرون أن الله أمر النبي والرسول بتبليغ ما أوحي إليهما، وإنما الفرق بينهما في
نزول الكتاب، فالرسول عندهم من بعثه الله تعالى إلى الخلق وأنزل عليه كتابا
كإبراهيم، وداود، وموسى، وعيسى، ومحمد e، أما النبي فمن لا كتاب له، وإنما أمر أن يدعو
إلى كتاب من قبله، إذن، فالرسول أخص من النبي، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا([132]).
حقيقة النبوة
يرى
الماتريدية أن النبوة منحة إلهية لا تنال بالاكتساب -أي بالمجاهدة والمعاناة-، ولا
تنال بمجرد التشهي والرغبة. وإنما هي هبة من الله تعالى، لقول الله عز وجل: )وَإِذَا
جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ
رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ( -الأنعام:
124-، يقول التفتازاني
موضِّحًا حقيقة النبوة بأنها اختيار من عند الله عز وجل: "البعثة لطف من الله
تعالى ورحمة للعالمين لما فيها من حكم ومصالح لا تحصى منها معاضة العقل قيما يستقل
بمعرفته مثل وجود الباري، وعلمه، وقدرته ... بل الله تعالى يختص برحمته من يشاء من
عباده"([133]).
والدليل على ذلك قوله e: (إن الله اصفطى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولده إسماعيل،
واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصفطى من قريش بني
هاشم، واصطفاني من بني هاشم) ([134]).
أورد هذا الحديث صاحب كتاب (إشارات المرام) ([135]).
وقد أكد هذا
المعنى صاحب (رسالة بيان الاعتقاد): "ولا يشترط في النبوة شرط من الأعراض
والأحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدات في الخلوات والآنقطاعات كما يزعمه الحكماء
بل الله يختص برحمته من يشاء من عباده والنبوة رحمة وموهبة بمشيئة الله
تعالى"([136]).
واتضح من هذا
النص أن النبوة عند الماتريدية اختيار من الله واصطفاء لا تبلغ بكسب ولا بغيره.
العصمة والمعجزة
ذهب الماتريدية إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر، أي من جميع
المعاصي، ومن الكفر لأنه أكبر الكبائر، ولكونه سبحانه وتعالى: )إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً( -النساء: 48-. والقبائح أو الفواحش وهي أخص من الكبائر في مقام التغاير،
كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: )لَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ( -الشورى، 37-([137]). وعصمة الأنبياء ثابتة لهم قبل النبوة وبعدها على الأصح، وهم مؤيدون
بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، لكن كانت منهم أي من بعض الأنبياء قبل ظهور
مراتب النبوة أو بعد ثبوت مناقب الرسالة (زلات) أي عثرات بالنسبة إلى مالهم من على
المقامات وثنى الحالات، كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام في أكله من الشجرة على
وجه النسياء، أو ترك العزيمة، واختيار الرخصة ظنا منه أن المراد بالشجرة المنهية
المشار إليها بقوله تعالى: )وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ( -البقرة، 35-. هي الشخصية لا الجنسية، فأكل من الجنس لا من الشخص بناء
على الحكمة الإلهية ليظهر ضعف قدرة البشرية، وقوة اقتضاء مغفرة الربوبية([138]).
وأما الإمام الماتريدي فذهب إلى القول بعدم جواز الكبائر على الأنبياء بعد
البعثة، أما الصغائر فقد أجازها، وفي هذا يقول الإمام أبو حنيفة: "إن
الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح،
وقد كانت منهم زلات وخطيئات، ومحمد عليه الصلاة والسلام نببيه وعبده ورسوله ونبيه
وصفيه ونقيه، ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة
ولا كبيرة قط"([139]). وذكر ملا
علي القارئ أن الإمام الماتريدي قال: "إن العصمة لا تزيل المحنة أي الإبتلاء
والإمتحان يعني لا تجبره على الطاعة، ولا تعجزه عن المعصية، بل هي لطف من الله
تعالى بحمله على فعل الخير، ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للإبتلاء
والإختيار"([140]).
وأوضح كمال الدين البياضي المعجزة بأنها: "أمر خارق للعادة، مقرون
بالتحدّي مع عدم المعارضة، فعمم بالأمر للفعل كانفجار الماء من بين الأصابع، وعدمه
كعدم إحراق النار"([141]). وقال أبو
المعين السنفي في تعريفه للمعجزة: "وحدُّها على طريق المتكلمين، أنها ظهور
أمر بخلاف العادة، في دار التكليف، لإظهار صدق مدّعي النبوة، مع نكول من يتحدى به
عن معارضته بمثله. وإنما قيد بدار التكليف، لأنها مدّعي النبوة، ليقع الاحتراز به،
عما يظهر مدّعي الألوهية، إذ ظهور ذلك على يده جائز عندنا، وفيه أيضا احتراز عما
يظهر على يد الولي، إذ ظهور ذلك كرامة للولي جائز عندنا. وإنما قلنا لإظهار صدقه،
لأن ذلك لو ظهر لإظهار كذبه ... لا يكون ذلك معجزة له، ولا دليلا على صدقه، بل
يكون دليلا على كذبه في دعواه. وإنما قلنا مع نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله،
لأن الناقض للعادة لو ظهر على يده، ثم ظهر على يد المتحدي به مثله، لخرج ما ظهر
على يده عند المعارضة عن الدلالة، إذ مثله ظهر على يدي من يكذبه، يكون دليل صدق من
يكذبه، فيكون دليل كذبه، فيتعارض الدليلان فيسقطان.
ورأي
المذهب الماتريدي بأن النبوة تثبت بطريقين:
- الأول: النظر
في صفات الأنبياء والخلقية قبل الرسالة وبعدها.
- الثاني:
تأييد الله تعالى لهم بالمعجزات والآيات والبراهين الدالة على صدقهم.
ونص على ذلك
الإمام الماتريدي، حيث قال: "ثم الأصل عندنا في إعلام الرسل وجهان: أحدهما
ظهور أحوالهم على جهة تدفع العقول عنهم الريبة وتأبى فيهم توهم الظنة بما صحبوهم
في الصغر والكبر فوجدوهم طاهرين أصفياء أتقياء بين أظهر قوم ما احتمل التسوية
بينهم على ذلك ولا تربيتهم تبلغ ذلك على ظهور أحوالهم لهم وكونهم بينهم في القرار
والانتشار فيعلم بإحاطة أن ذلك حفظ من يعلم أنه يقيمهم مقاما شريفا ويجعلهم أمناء
على الغيوب والأسرار وهذا مما تميل إلى قبوله الطبيعة ويستحسن جميع أمورهم
العقل فيكون الراد عليه يرد بعد المعرفة رد تعنت له ... والثاني مجيء الآيات
الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع الممتنعة عن أن يطمع في مثلها أو يبلغ
بكنهها التعلم مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فإن الرسل بما
نشؤوا لا في ذلك وربوا لا به يظهر أنهم استفادوه بالله أكرمهم بذلك لما يجعلهم
أمناء على وحيه"([142]).
وقد
بين سعد الدين التفتازاني بأنه: "قد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين:
أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل
النبوة، وحال الدعوة، وبعد تمامها، وأخلاقه العظيمة، وأحكامه الحكيمة، وإقدامه حيث
تحجم الأبطال، ووثوقه بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال، وثباته على حاله لدى
الأهوال، بحيث لم يجد أعداؤه مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا، ولا إلى
القدح فيه سببا، فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء، وأن
يجمع الله هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفري عليه، ثم يمهله ثلاثا وعشرين سنة،
ثم يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه، ويحي آثاره بعد موته إلى يوم
القيامة.
- وثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر
العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم، ولا حكمة معهم، وبين لهم الكتاب والحكمة، وعلمهم
الأحكام والشرائع، وأتم مكارم الأخلاق، وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية
والعملية، ونور العالم بالإيمان، والعلم الصالح، وأظهر الله دينه على الدين كله
كما وعده، ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك([143]).
فهذه
النصوص تثبت لنا على أن الإمام الماتريدي ذهب إلى القول بأن إثبات النبوة يكون
بهذين الطريقين، أي بالنظر إلى أحوال النبي -قبله وما بعده-، وبوجود المعجزة.
وأما جمهور
الماتريدية فاكتفوا بالطريق الثاني، حيث يرون أنه لا دليل على صدق النبي e غير
المعجزة بحجة أن المعجزة وحدها هي التي تفيد العلم اليقيني بثبوت نبوة النبي أو
الرسول، وقد بين ذلك أبو السير البزدوي: "لا يتصور ثبوت الرسالة بلا دليل
فيكون الثبوت بالدلائل وليست تلك الدلائل إلا المعجزات فثبتت رسالة كل رسول
بمعجزات ظهرت على يديه فكانت معجزات موسى عليه السلام العصا واليد البيضاء وغيرهما
من المعجزات ومعجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير
ذلك ومعجزات محمد عليه السلام القرآن فإن العرب بأجمعهم مع فصاحتهم عجزوا عن
الإتيان بمثله ... فعجزوا عن ذلك فكانت المعجزات دليل صدق دعواهم الرسالة فإن ما
ظهر ليس في وسع بشر فعلم أن الله هو المنشئ وإنما ينشئها لتكون دليلا على صدق
دعواه فإن قوم كل رسول سألوا منه دلائل صدقه فدعا الله تعالى ليؤيده بإعطاء ما
طلبوا منه فلما أعطاه دليل صدقه الذي طلب منه قومه صار ذلك دليل صدقه من الله
تعالى فإن الله لا يؤيد الكاذب ... ولابد للناس من معرفة الرسل ولا طريق للمعرفة
سوى المعجزات"([144]).
وممن ذهب إلى
هذا القول أبو المعين النسفي، ونص قوله: "إذا جاء واحد وادعى الرسالة في زمان
جواز ورود الرسل ... لا يجب قبول قوله بدون إقامة الدليل .... لما أن تعين هذا
المدعي للرسالة ليس في حيز الواجبات لانعدام دلالة العقل على تعينه فبقي في حيز
الممكنات وربما يكون كاذبا في دعواه فكان القول بوجوب قبول قوله قولا بوجوب قبول
قول من يكون قبول قوله كفرا وهذا خلف من القول وإذا لم يجب قبول قوله بدون الدليل
يطالب بالدليل وهو المعجزة"([145]).
وفي موضع آخر،
ذهب نجم الدين الناصري إلى أن المعجزة رأس الحجج وأهم الدلائل على إثبات النبوة،
حيث قال: "فالمعجزة توجب علم اليقين بنبوة الرسل بواسطة التأمل وترك الإعراض
عن النظر فيها وإنما جهل من جهل بعد ظهور آيات الرسل بترك التأمل ولم يعذر بالترك
لأن العقل مما يلزمه التأمل فيها لأنه حجة من حجج الله تعالى وهي تتعاضد ولا تتضاد
ولو كانت الحجج موجبة للعلم جبرا لما تعلق بها ثواب ولا عقاب فالمعجزة رأس الحجج
وهي تزداد عند البحث والتأمل إيضاحا واستنارة وقوة ووكادة"([146]).
فهذا النص يدل
على اعتبار الطريق الأول وهو إثبات النبوة بأحوال النبي، ولكن على الرغم من ذلك أن
المعجزة من أهم الطرق وأفضلها عند الناصري.
وعلى أية حال،
فإن المعجزة عند الماتريدية لازم من لوازم النبوة، ودليل صحيح لتقرير نبوة
الأنبياء. وفي يقول صاحب (رسالة بيان الاعتقاد): "والنبوة رحمة وموهبة بمشيئة
الله تعالى فقط ولابد من معجزة وهي عبارة عما قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول
الله"([147]).
وقد اشترط
الماتريدية في المعجزة شروطا عامة أو على الإجمال كخرق العادة، والتحدي، وعدم
المعارضة. وأما على التفصيل فهي كالآتي:
- الأول: أن يكون الأمر الخارق فعل
الله تعالى.
- الثاني: أن يكون خارقا للعادة.
- الثالث: أن يتعذر معارضته.
- الرابع: أن يكون مقرونا بالتحدي.
- الخامس: أن يكون موافقا للدعوى.
- السادس: أن لا يكون من ادعاه
وأظهره مكذبا له.
- السابع: أن لا تكون المعجزة متقدمة
على الدعوى، بل مقارنة لها، أو متأخرة عنها بزمن يسير بعتاد مثلها([148]).
وثمة أمر آخر،
أن الماتريدية كما أنهم يثبتون معجزات الأنبياء فهم يثبتوت أيضا كرامات الأولياء
ويرون أنه لا فرق بينهما إلا التحدي الذي هو دعوى الرسالة، وعرف أبو المعين النسفي
الكرامة قائلا: "وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله، غير مقارن لدعوى
النبوة"([149]).
وأما الولي فهو العارف بالله تعالى، وصفاته بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات،
المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات([150]).
وعن إثبات
كرامات الأولياء وأنها حق يقول أبو المعين النسفي: "وظهور الكرامة على طريق
نقض العادة للولي جائز عندنا غير ممتنع"([151]).
وأكد ذلك ملا علي القاري: "والكرامات للأولياء حق، أي ثابت بالكتاب والسنة،
ولا عبرة بمخالفة المعتزلة، وأهل البدعة في إنكار الكرامة"([152]).
واضح من هذه
النصوص أنه من لم يكن بهذه الصفات، وظهر على يده خوارق للعادة، فوافق مراده وغرضه،
فإن يكون استدراجا، كما حصل لإبليس من طي الأرض له حتى يوسوس لمن في الشرق والغرب،
وإن لم يوافق غرضه ومراده يكون إهانة، كما روي أن مسيلمة الكذاب دعا الأعور أن
يصير عينه العوراء صحيحة فصارت عنه الصحيحة عوارء. وإن ظهر الخارق من قبل عوام
المسلمين، تخليصا لهم عن المحن والمكاره، فهذا يكون معونة([153]).
إذن فالفارق
الأساسي بين المعجزة والكرامة هو الدعوى بالنبوة والتحدي، يقول ملا علي القاري:
"والكرامة خارق للعادة، إلا أنها غير مقرونة بالتحدي، وهي كرامة للولي،
وعلامة لصدق النبي، فإن كرامة التابع كرامة المتبوع"([154]).
فكل ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي([155]).
وهذا يدل على
كرامة الولي من معجزات النبي ودليل على صدقه، بل كل كرامة للولي تكون معجزة
للرسول، لأن كرامة التابع كرامة المتبوع، والولي لا يكون كذلك حتى يكون مصدقا
بالنبي e، ومتبعا له.
وهذا ما جزمه أبو المعين النسفي فقال: "بل كل كرامة للولي تكون معجزة لرسول،
فإن ظهورها يعلم أنه ولي، ولن يكون وليا، إلا وأن يكون محقا في ديانته، إذ المعتقد
دينا باطلا عدو لله لا وليه، وكونه محقا في ديانته، وديانة الإقرار برسالة رسوله،
واتباعه إياه في دينه، دليل صحة رسالة رسوله"([156]).
ولا نوافق هذه
التفرقة، لأنهم جعلوا ما كان من معجزات للأنبياء كرامات للأولياء، فلا فرق عند
الماتريدية بينهما إلا دعوى النبوة والتحدي بالمثل. مع أن معجزات الأنبياء التي
دلت على نبوتهم، هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم. فانشقاق القمر، والإتيان
بالقرآن، وانقلاب العصا حية، وخروج الدابة من الصخرة، لم يكن مثله للأولياء.
وهناك فوارق
أخرى عند الماتريدية كرأيهم بأن المعجزة لا بد فيها من علم النبي e بكونه
نبيا، وأما الولي فلا يلزم علمه بكونه وليا. وكذلك أن المعجزة يقصد النبي إظهارها،
والحكم قطعا بموجبها، وأما الولي فيجتهد في كتبمانها، ويخشى أن تكون استدراجا،
ويخاف من الاغترار بها إذا اشتهرت. وأن الكرامة تكون مقارنة للعمل الصالح،
والاعتقاد الصحيح، وتبعث على الجد والاجتهاد في العبادة، والاحتراز عن السيئات([157]).
والأدلة على
ثبوت الكرامة عند الماتريدية قوله تعالى: )كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا
مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ
مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ( -آل عمران، 37-. فظهر لها من الطعام والشراب واللباس عند
الحاجة، ما لم يظهر لغيرها. وما ذكره الله عن إتيان صحاب سليمان عليه السلام، بعرش
بلقيس قبل ارتداد الطرف، مع بعد المسافة، قال تعالى: )قَالَ الَّذِي
عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ( -النمل،
40-. إضافة إلى الأخبار المنقولة عن الصحابة ومن بعدهم. منها ما يكون فيه اندلاع
المتوجه من البلاء، وكفاية المهم من الأعداء، مثل قول عمر بن الخطاب t وهو على
المنبر بالمدينة، وجيشه بنهاوند، "يا سارية الجبل، تحذيرا له من وراء الجبل،
لمكر العدو هناك، وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة، وكشرب خالد بن الوليد t السم من
غير تضرر به، وكجريان النيل بكتاب عمر t، وأمثال هذا كثير.
فهذه أدلة على
ثبوت الكرامة عند الماتريدية، قال التفتازاني: "والدليل على حقية الكرامة، ما
تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم، بحث لا يمكن إنكاره، خصوصا الأمر المشترك،
وإن كانت التفاصيل آحادا، وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم، ومن صاحب سليمان
عليه السلام، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز([158]).
وقال أبو
المعين النسفي ردا على المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء: "ظهور الكرامة
على طريق نقض العادة للولي جائز عندنا غير ممتنع ... وأهل الحق أقروا بذلك بما
اشتهر من الأخبار، واستفاض من الحكايات عن الأخبار ... فلا وجه إلى رد ما انتشر به
الخبر عن صالحي الأئمة في ذلك . وما ظنوا -أي المعتزلة- أنه يؤدي إلى انسداد طريق
الوصول إلى معرفة النبي والرسول ... فظن باطل، بل كل كرامة للولي تكون معجزة
لرسول، فإن بظهورها يعلم أنه ولي، ولن يكون واليا إلا وأن يكون مؤمنا برسالة
رسوله، فمن جعل ما هو معجزة للرسول ودلالة صدقه، مبطلا للمعجزة، وسادا لطريق
الوصول إلى معرفتها، فقد وقع في غلط فاحش، وخطأ بين. ثم كيف يؤدي ذلك إلى التباء
الكرامة للمعجزة، والمعجزة تظهر على أثر الدعوة، والولي لو ادعى الرسالة لكفر من
ساعته، وصار عدوا لله -تعالى-، ولا يتصور بعد ذلك ظهور الكرامة على يده. وكذا صاحب
المعجزة لا يكتم معجزته، بل يظهرها، وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها"([159]).
المبحث الرابع
النبوة عند الظاهرية
حكم بعثة الرسل
يذهب الظاهرية
إلى القول بإمكان بعثة الرسل من الله عقلا، أي أن النبوة ليست واجبة أن تكون ولا
ممتنعة أن تكون، وإنما النبوة تدخل في باب الممكن العقلي، فلا
وجوب علي الله عز وجل، ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرط عليه، ولا علة
موجبة لشيئ من أفعاله([160])،
يقول ابن حزم بأنها: "ممكنة بالقوة بما يوجبه أن محدث العالم مختار لا يعجزه
عن شيء، ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية، نظر في النبوات التي
افترقت عليها الملل، فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد منهم، فواجب أن تثبت
بمثله نبوة من نقل عنه مثل الذي نقل عن غيره منهم، وقف عند ذلك وسلم الأمر إلى من صحت
له البراهين بنبوته، وأنه عن الله عز وجل يتكلم وعن عهوده يخبر، ويبحث، حينئذ عن
كل ما أمر به أو نهي عنه فاستعمل نفسه به، ولم يقبل من إنسان مثله لم يؤيد بوحي من
الله، عز وجل، أمراً ولا نهياً"([161]).
إذن، فإن معنى
الإمكان العقلي للنبوة متضمن في معنى اختيار الكائن اللامتناهي القدرة. والذي لا
يعجزه شيء. وبالتالي فليست النبوة مما يعارض المعقول. وبهذا وافق الظاهرية رأي
الأشاعرة والماتريدية في البعثة، وقالوا بأن النبوة حق([162])،
لأنه ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف إلا بالخبر عنه. وخبر التواتر يوجب
العلم الضروري ولا بد ولو دخلت في نقل التواتر داخلة أو شك لوجب أن يدخل الشك -في
أنه- هل كان قبلنا خلق أم لا؟، إذا لم نعرف كون الخلق موجودا قبلنا إلا بالخبر،
ومن يلغ ههنا فقد فارق المعقول([163]).
ويرد الظاهرية
على منكري النبوات من أمثال ابن الرواندي وأبو بكر الرازي([164])، حيث أنكروا
النبوات عامة بما في ذلك نبوة محمد e، فيتهمهم ابن حزم بالجهل والخروج عن حدّ
المعقول، ذلك لأنهم لا يصدقون بشيء إلا بعد مشاهدته مشاهدة حسية، ويلزم من ذهب هذا
المذهب أن لا يصدق بأن أحدا كان قبله، ولا أن في الدنيا أحدا إلا من شاهده بحسه،
فإن جوز هذا خرج عن حدود المناظرة، ولحق المجانين. أما إن امتنع عن تجويز هذا،
وأقر بأن قد كان قبله وقائع وأمم معروفة، وأن في الدنيا بلادا لم يشاهدها، سئل: من
أين عرفت ذلك؟، وكيف صح عندك؟ فلا سبيل أن يأتي بغير نقل الكواف، وبالله التوفيق([165]).
ويذكر ابن حزم
أنه إذا كان الخلق لا يقع منهم الفعل إلا لعلة، فإن الباري جل وعز خلاف جميع خلقه
من جميع الجهات، فلما كان كذلك، وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال الخلق، ولا
يجب أن يقال في شيء من أفعاله لم فعل هكذا؟ فإذا حبا إنسان بشيء، وحرمه سائر
البشر، فليس لأحد أن يقول لم فعل هذا؟ وليس لأحد أن يسأل مثل الأسئلة السابقة، فإن
الله تعالى: )لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ( -الأنبياء،
23-. وما كان ممتنعا بيننا، أو ليس ببنيتنا، ولا من عادتنا، فهو غير ممتنع على
الذي لا بنية له، ولا عادة عنده الذي )إِنَّمَا
أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْن( -يس،
82-. فإذا صح هذا، وعلمنا أنه تعالى لا نهاية لقوله، ولا نهاية لما يقوى عليه، فقد
صح أن النبوة في قوم خصهم الله، في بعض الأماكن بالفضيلة ببعثهم ... فعلهم العلم
دون تعلم([166]).
الفرق بين النبي والرسول
والنبوة هي
الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموحى إليه بأمرما يعلمه لم يكن يعلمه قبل.
والرسالة هي النبوة وزيادة وهى بعثته إلى خلق ما بأمرما، هذا ما لا خلاف فيه([167]).
والخضر عليه السلام نبي قد مات. ومحمد e لا نبي بعده. قال الله عز وجل حاكيا عن
الخضر: )وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع
عَّلَيْهِ صَبْراً( -الكهف، 82-. فصحت نبوته، وقال تعالى: )مَا كَانَ
مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً( -الأحزاب،
40-([168]).
ويشرح ابن
حزم أن النبي e وهو رسول الله مبعوث للعالمين جميعا، فأرسله الله إلى جميع
الإنس والجن كافرهم ومؤمنهم، وبرهان ذلك: أنه e أتى بهذا القرآن المنقول إلينا بأتم ما
يكون من نقل التواتر وأنه دعا من خالفه إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا كلهم عن ذلك.
والدليل على أنه مبعوث إلى جميع الخلق من الإنس والجن قوله تعالى: )قُلْ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ
بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( -الأعراف،
158-. وقال تعالى: )يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا
قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ( -الأنعام،
130-. وقال تعالى: )قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا
بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً( -الجن،
1، 2-. إلى قوله: )وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ
أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا
لِجَهَنَّمَ حَطَباً( -الجن، 14، 15-. وقال تعالى: )وَمَن
يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ( -آل عمران، 85-([169]).
حقيقة النبوة
يرى
الظاهرية أن النبوة ليست علما مكتسبا، وإنما تكون بإخبار الملك، وبوحي صادق، ولا
سبيل لغيره إلى الوصول إلى مثله، إلا ما خصه الله عز وجل بذلك، بدون أن يكون الذي
نبئ في ذلك عمل، وإنما هي أن يكون المرء يعلمه الله تعالى علوما يعلم بها، دون أن
يتعلمها ولا يكتسبها، فهذه حقيقة معنى النبوة([170]).
إن هذ الموقف
يقتضي النظر إلى علم النبوة، أو جملة المعارف التي يأتون بها، على أنها من عند
الله بسبب من دليل المعجزة. فهم والحالة هذه حصلوا عليها لا بتعلم أو نقل في طلب
العلم، وإنما بضرب من الهبة أو المنحة الإلهية التي يخص بها الله من شاء من عباده،
يقول ابن حزم: "النبوة في قوم خصهم الله في بعض الأماكن بالفضيلة لا لعلة،
إلا أنه تعالى شاء ذلك، فعلمهم العلم دون تعلم، ولا ينتقل في مراتبه ولا طالبا له([171]).
ومن
هنا، فإن كلام النبي e كله من عند الله عز وجل، قال الله تعالى: )وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى( -النجم:
3-. وقال الله تعالى: )وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ
اخْتِلاَفاً كَثِيْراً( -النساء: 82-. وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه([172]).
ويستدل
الظاهرية على أن النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل وأن الله كلم موسى عليه
السلام ومن شاء من رسله بقوله تعالى: )قَالَ يَا
مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ
مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ( -الأعراف،
144-. وقوله تعالى: )وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً( -النساء،
164-. وقوله تعالى: )تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن
كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ( -البقرة،
253-([173]).
العصمة والمعجزة
يرى الظاهرية
بعصمة الأنبياء والرسل أي أن جيع هؤلاء الأنبياء والرسل لا يذنوبون([174]). ويوضح
ابن حزم أن الذين يوجبون أن الأنبياء قد اجترحوا السيئات، لا يخلو أمرهم من أحد
وجهين لا ثالث لهما:
- الأول: إما أن يقولوا: "إن في
الناس من لم يعص قط، ولا اجترح سيئة".
- والثاني: أو يقولون: "إنه ليس
في الدنيا أحد إلا وقد اجترح سيئة".
فإن قالوا ليس
في الناس أحد إلا وقد اجترح سيئة (بما في ذلك الأنبياء من حيث إنهم ناس)، قيل لهم:
فمن هؤلاء الذين نفى الله عنهم أن يكون الذين اجترحوا السيئات إذا كانوا غير
موجودين في الناس؟. فلا بد لمن قال هذا القول من أن يجعل كلام الله هذا لا معنى
له، وهذا كفر من قائله. فإن قال: هو الملائكة الذين ينطبق عليهم هذا القول، قيل
له: هذا يخالف قوله تعالى: )أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ
سَاء مَا يَحْكُمُونَ( -الجاثية، 21-. ولا دليل على أن الملائكة تموت، إذا لم يأت
بذلك دليل ولا إجماع، بل الدليل يوجب أنهم لا يموتون، لأن الجنة دار لا موت فيها،
وهم سكان الجنة، وسكان ما حوالي العرش، بحيث لا موت ولا فناء.
وإن قالوا إن
في الناس من لم يجترح سيئة قط، وأن من اجترح السيئات لا يساويهم، فإن قال أحد ذلك،
مع قوله: إن الأنبياء يعصون عمدا ويجترحون السيئات، لزمه أن يقول: إن في الناس من
لم يجترح سيئة قط، ومنهم من هو أفضل من الأنبياء، وهذا كفر من قائله.
فإذن، صح
بالنص أن في الناس من لم يجترح سيئة قط، وأن من اجترح السيئات لا يساويهم عند ربهم
عز وجل، فالأنبياء عليهم السلام أحق بهذه الدرجة([175]).
وأن المعجزات
لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام([176]). قال
عز وجل ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ
إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ( -الرعد،
38-. وقال تعالى: ) وَإِن يَرَوْا
آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ( -القمر،
2-. وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال: )قَالَ
أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (-الشعراء،
30،31، 32-. وقال تعالى: )فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ( -القصص،
32-.
فصح أنه لو
أمكن أن يأتي أحد -ساحر أو غيره- بما يحيل طبيعة أو يقلب نوعا، لما سمى الله تعالى
ما يأتي به الأنبياء عليهم السلام برهانا لهم ولا آية لهم، ولا أنكر على من سمى
ذلك سحرا ولا يكون ذلك آية لهم عليهم السلام. ومن ادعى أن إحالة الطبيعة لا تكون
آية إلا حتى يتحدى فيها النبي e الناس فقد كذب وادعى ما لا دليل عليه أصلا، لا من عقل ولا من
نص قرآن ولا سنة، وما كان هكذا فهو باطل، ويجب من هذا أن حنين الجذع وإطعام النفر
الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا وهم مئون من صاع شعير، ونبعان الماء من بين
أصابع رسول الله e وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر - ليس
شيء من ذلك آية له عليه السلام لأنه عليه السلام لم يتحد بشيء من ذلك أحدا([177]).
ويستند ابن
حزم على حصول النبوة وأنها وجبت، بتأكيد الخبر الموثوق لذلك، إذ يقول: "بنقل
التواتر المذكور صح أن قوما من الناس أتوا أهل زمانهم يذكرون أن الله تعالى خالق
الخلق أوحى إليهم يأمرهم بإنذار قومهم بأوامر ألزمهم الله تعالى إياها، فسألوا
برهانا على صحة ما قالوا: فأتوا بأعمال هي خلاف لطبائع ما في العالم لا يمكن ألبتة
في العقل أن يقدر عليها مخلوق، حاشا خالقها الذي ابتدعها كما شاء، كقلب عصا حية
تسعى، وشق البحر لعسكر جازوا فيه وغرق من اتبعهم؛ وكإحياء ميت قد صح موته، وكإبراء
أكمه ولد أعمى، وكناقة خرجت من صخرة، وكإنسان رمي في النار فلم يحترق وكإشباع
عشرات من الناس من صاع شعير وكنبعان الماء من بين أصابع إنسان حتى روى العسكر كله.
فصح ضرورة أن الله تعالى شهد لهم بما أظهر على أيديهم بصحة ما أتوا به عنه وأنه
تعالى صدقهم فيما قالوه"([178]).
وإذن،
فإن التثبت من وجود الأنبياء يتم بتواتر الخبر عنهم، فوجودهم التاريخي حقيقة
واقعة، بيد أن التثبت من كونهم أنبياء بالفعل فدليله "المعجزة" فحيث ثبت
بالتواتر، وجود الرسل، ومصاحبة المعجزات لهم، التي تخرق الطبائع، وتحيل الممتنع في
قدرة البشر ممكنا، بل واجبا، فلا بد من ربط هذا الخرق بمن يقدر عليه، يقول ابن
حزم: " علمنا بكل ما قدمنا، من أنه تعالى مرتب هذه المراتب التي في العالم،
ومجريها على طبائعها المعلومة منا، الموجودة عندنا، وأنه لا فاعل على الحقيقة غيره
تعالى، ثم رأينا خلافا لهذه الرتب والطبائع قد ظهرت، ووجدنا طبائع قد أحيلت وأشياء
في حد الممتنع قد وجبت ووجدت، كصخرة انلفتت عن ناقة، وعصا انقلبت حية، وميت أحياه
إنسان، ومئين من الناس رووا وتوضأوا كلهم من ماء يسير في قدح صغير يضيق عن بسط
اليد فيه، لا مادة له. فعلمنا أن محيل هذه الطبائع، وفاعل هذه المعجزات، هو الأول
الذي أحدث كل شيء([179]).
هكذا فإنه
مادام أن المعجزات قد حدثت بنقل الكافة -كما يرى ابن حزم-، وقد صاحبت هذه المعجزات
الرسل تأييدا لهم، وأنها تحيل طبيعة ليس في مقدور البشر إحالتها، بل ذلك لله وحده
لأنه خالقها، فهذا دليل على أن من رافقت دعواه المعجزات صادق فيما يخبر به. وليس
من داع بعد ذلك لجحد الرسالة التي جاؤوا بها، لأننا قد استوثقنا من صدق الرسل
بشهادة ربهم لهم، بموجب المعجزات التي فعلها لتأييدهم فيما يدعون([180]).
وقد صح
للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على صحة نبوتهم وجود ذلك بالمشاهدة ممن شهدهم
ونقله إلى من لم يشاهدهم بالتواتر الموجب للعلم الضروري فوجب الإقرار بذلك وبقي ما
عدا أمر الأنبياء عليهم السلام على الإمتناع فلا يجوز البتة وجود ذلك لا من ساحر
ولا من صالح بوجه من الوجوه لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك ولا صح به نقل وهو ممتنع
في العقل كما قدمنا ولو كان ذلك ممكنا لاستوى الممتنع والممكن والواجب وبطلت
الحقائق كلها([181]).
وعلى أية حال،
فإن الأصل -عند الظاهرية- في تصديق الرسالة أي صدق الرسول الذي وثقنا بكلامه،
بشهادة ربه له بموجب المعجزة، وبما أن الأمر كذلك، وأن الرسالة ذاتها قد أوجبت، أن
الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا فرق بين القرآن والسنة الصحيحة،
من حيث وجوب أخذهما على محمل واحد، فهما يصدران عن الشخص نفسه، أي الرسول، وهو
مؤتمن. ما يترتب عليه أن يكون لكل منهما القيمة نفسها في الأحكام، وفي الناسخ
والمنسوخ أيضا، "لأنه ليس شيء من كلامه عليه السلام أولى بالقبول من بعض، بل
الكل واجب قبوله، ولا تعارض في شيء منه، لأنه كله من عند الله. فصح بهذا م قلنا من
ضم ما يوجد في النصوص ضما واحدا وقبوله كله، وإضافته بعضه إلى بعض([182]).
ومن
جانب آخر أنكر المذهب الظاهري الكرامات وهي
فعل خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، وقالوا بأنها شيء مستحيل، لأن الله في
رأيهم قد اختص الأنبياء بالمعجزات الدالة على صدقهم، وهذه المعجزات هي المفرقة بين
دعوى المدعيين، وبين الأنبياء، فلو جاز أن يأتي بهذا الأمر أحد سواهم، لما كان فيه
دليل على صدقهم([183]).
إذن، فلا يمكن
صدور الكرامات من الأولياء، وكذلك لا يمكن قلب الأعيان والطبائع من طرف السحرة،
يقول ابن حزم: "لا يجوز البتة وجود ذلك، لا من ساحر، ولا من صالح بوجه من
الوجوه، لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك، ولا صح به نقل، وهو ممتنع في العقل، كما
قدمنا ولو كان ذلك ممكنا لاستوى الممتنع والممكن والواجب، وبطلت الحقائق كلها،
ولكن كل ممتنع ومن لحق هاهنا لحق بالسوفسطائية على الحقيقة، ونسأل من جوز ذلك
للساحر والفاضل: هل يجوز لكل أحد غير هذين أم لا يجوز إلا لهذين فقط، فإن قال أن
ذلك للساحر والفاضل فقط، وهذا هو قولهم سألناهم عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس
ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد،
وإن قالوا إن ذلك جائز أيضا لغير الساحر والفاضل لحقوا بالسوفسطائية حقا، ولم
يثبتوا حقيقة وجاز تصديق من يدّعي أنه يصعد إلى السماء، ويرى الملائكة، وأنه يكلم
الطير، ويجتني من شجر الخروب، التمر والعناب، وأن رجالا حملوا وولدوا وسائر
التخليط الذي من صار إليه وجب أن يعامل بما هو أهله إن أمكن، أو أن يعرض عنه
لجنونه وقلة حيائه ... لا فرق بين من ادّعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى
الرافضة رد الشمس على علي بن أبي طالب مرتين حتى ادعى بعضهم أن حبيب بن أوس قال
... فردت علينا الشمس والليل راغم ... بشمس لهم من جانب الخدر تطلع ... نضا ضوءها
صبغ الدجنة وانطوى ... لبهجتها فوق السماء المرجع ... فوالله ما أدري على بدا لنا
... فردت له أم كان في القوم يوشع ... وكذلك دعوى النصارى لرهبانهم وقدمائهم فإنهم
يدّعون لهم من قلب الأعيان أضعافا ما يدّعيه هؤلاء، وكذلك دعوى اليهودي لأحبارهم
ورؤوس المثايب عندهم أن رجلا منهم رحل من بغداد إلى قرطبة في يوم واحد، وأنه أثبت
قرنين في رأس رجل مسلم من بني الإسكندراني كان يسكن بقرطبة عند باب اليهود، وهذا
كله باطل موضوع وبنو الإسكندراني كانوا أقواما أشرافا معروفين لم يعرف لأحد منه
شيء من هذا والحماقة لا حدّ لها وهذا برهان لمن نصح نفسه"([184]).
وأما السحر
فإنه ضروب منه ما هو من قبل الكواكب كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون
القمر في العقرب، فينفع إمساكه من لدغة العقرب، ومن هذا الباب كانت الطلسمات وليست
إحالة طبيعية ولا قلب عين، ولكنها قوى ركبها الله عز و جل مدافعة لقوى أخرى، كدفع
الحر للبرد، ودفع البرد للحر، وكقتل القمر للدابة الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا
كانت دبرتها مكشوفة للقمر، ولا يمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا أنفسنا آثارها
ظاهرة إلى الآن من قرى لا ندخلها جرادة ولا يقع فيها برد وكسرى قسطة التي لا
يدخلها جيش إلا أن يدخل كرها وغير ذلك كثير جدا لا ينكره إلا معاند، وهي أعمال قد
ذهب من كان يحسنها جملة وانقطع من العالم ولم يبق إلا آثار صناعاتهم فقط ومن هذا
الباب كان ما تذكره الأوائل في كتبهم في المويسيقا و أنه كان يؤلف بين الطبائع
وينافر به أيضا بينها ونوع آخر"([185]).
ومن هنا رفض
ابن حزم رأي العلماء بأن السحر يحيل الأعيان ويقلب الجواهر وغيّر الطبائع، وتساءل:
"إذا جاز هذا، فأي فرق بين النبي والسحر؟، أفكان جميع الأنبياء سحرة كما قال
فرعون عن موسى: )إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ( -طه،
71-؟. وإذا جاز أن يقلب سحرة موسى عصيهم وحبالهم حيات، وقلب موسى عصاه حية، وكان
كلا الأمرين حقيقة، فقد صدق فرعون -بلا شك- في أن موسى ساحر مثلهم، إلا أنه أعلم
منهم به فقط، وحاشا لله من هذا، بل ما كان فعل السحرة إلا من حيل العجائب فقط ...
وأضاف بأن السحرة، إنما تخيل بحيل معروفة، إذا تدبرت، ووفقت عليها، ولو جاز أن
يقلب الساحر عينا، لما كان بين الأنبياء وبينه فرق، وقلب الأعيان هو الفرق بين
النبي وبين الساحر، وهذا الفرق يكون من عند الله بين الحق الظاهر على أيدي
الأنبياء، وبين الباطل الذي يلبس وهو السحر. وقد نص الله على ذلك فأخبر عن سحرة
موسى فقال: )يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى( -طه،
66-. فأخبر أن ذلك السحر إنما كان تخيلا لا حقيقة له، وقد قيل: إن تلك الحبال
والعصى كانت محشوة بالزئبق. وقد ذكر الله تعالى سحر هاروت وماروت، فلم يخبر عنه
بأكثر من التفريق بين المرء وزوجه، وهذا شيء يبطعه التخييل([186]).
وفي موضع آخر يقول ابن حزم: "والسحر حيل وتخييل، لا يحيل طبيعية أصلا، قال عز
وجل: )يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى( -طه،
66-. فصح أنها تخييلات لا حقيقة لها، ولو أحال الساحر طبيعة، لكان لا فرق بينه
وبين النبي. وهذا كفر ممن أجازه([187]).
وهكذا يفسر
ابن حزم السحر تفسيرا سيكولوجيا خالصا، ويرجعه إلى ضروب من حيل الحواة، تترك آثارا
نفسية شديدة توهم من يشاهدها بأنها حقائق، وما هي إلا أوهام وخيالات خادعة([188]).
ويتضح مما سبق
موافقة الظاهرية للمعتزلة في إنكار الكرامات. واستدلوا على ما ذهبوا إليه
بأنه لو جاز ظهور الخارق في حق الولي لخرج
الخارق عن كونه دليلا على النبوة. ونحترم رأي الظاهرية في هذه المسألة، إلا أنه
من واجبنا الرد عليهم -كما ثبت عند أدلة علماء الفرق الكلامية- أنه تمتاز المعجزة عن الكرامة
بشروط عدة منها اشتراط الدعوى في المعجزة وعدم اشتراطها في الكرامة، بل في الحقيقة
كرامة كل ولي معجزة لنبيه لدلالتها على حقيقة متبوعة.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





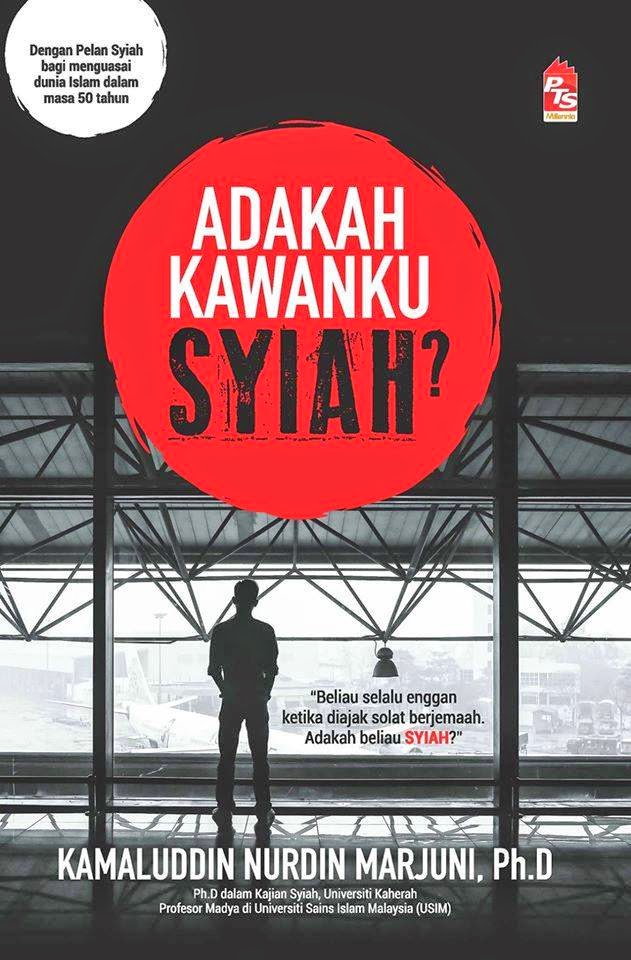

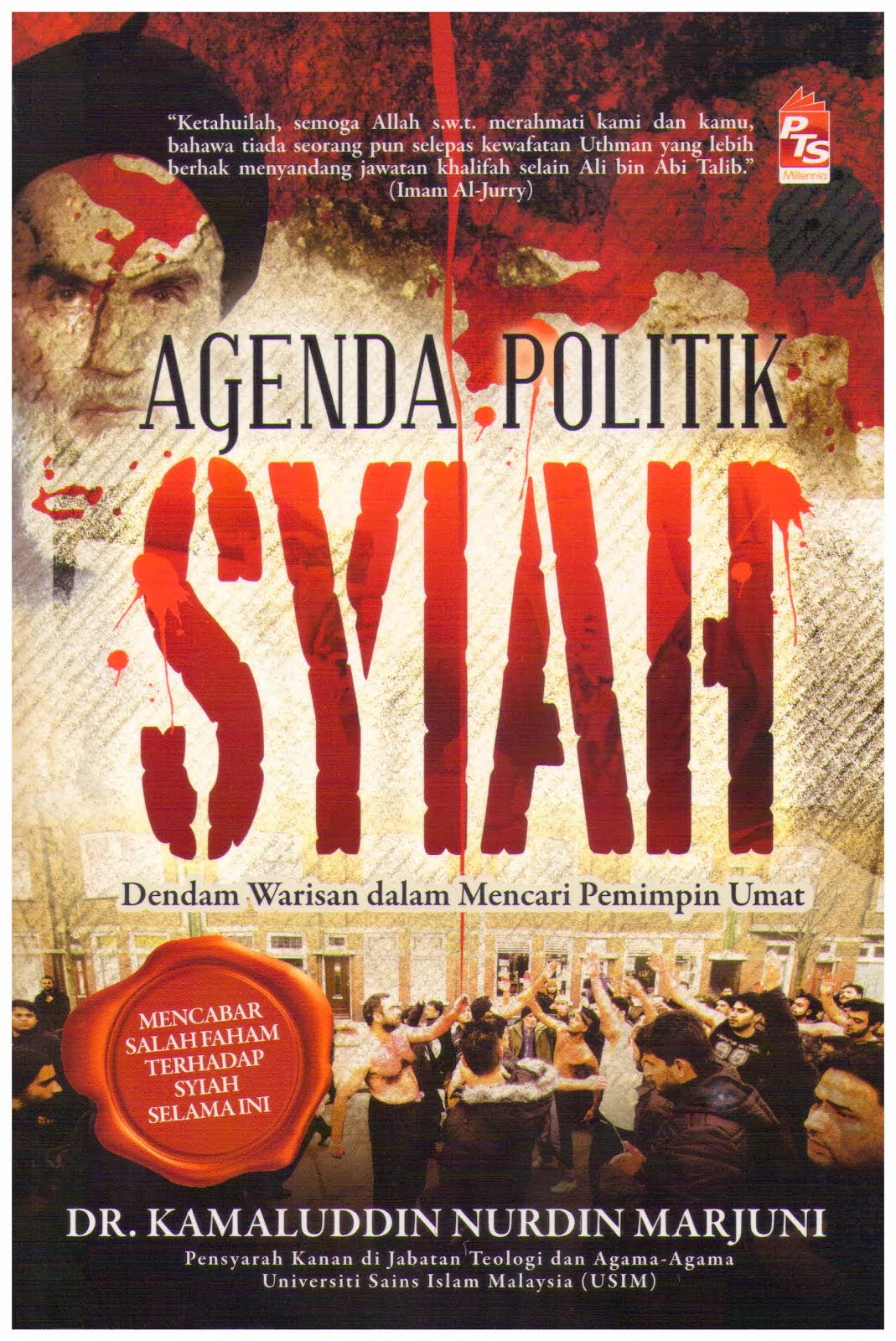



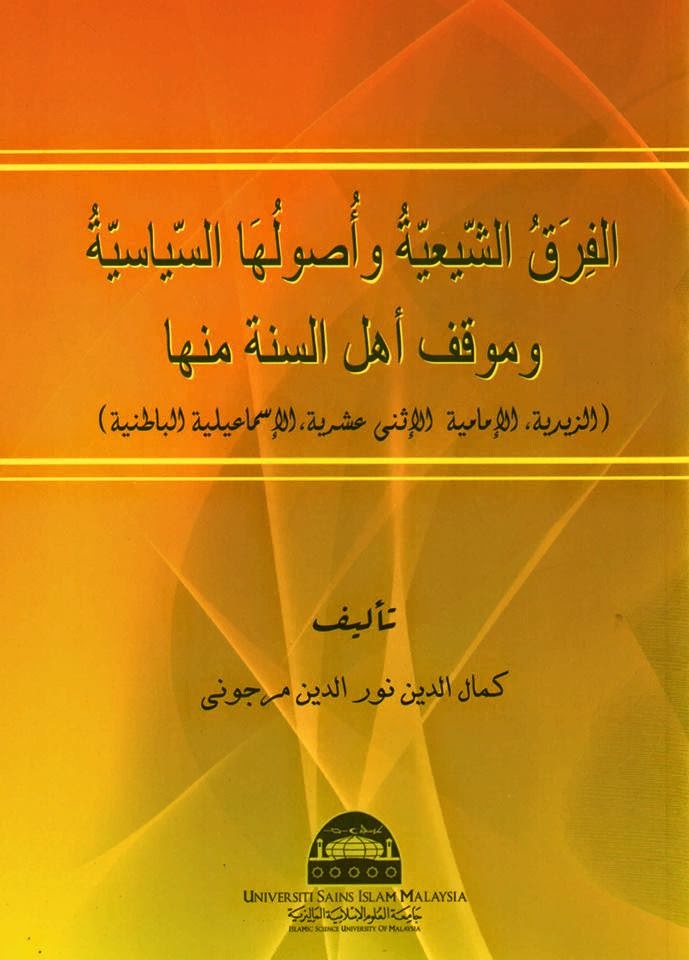





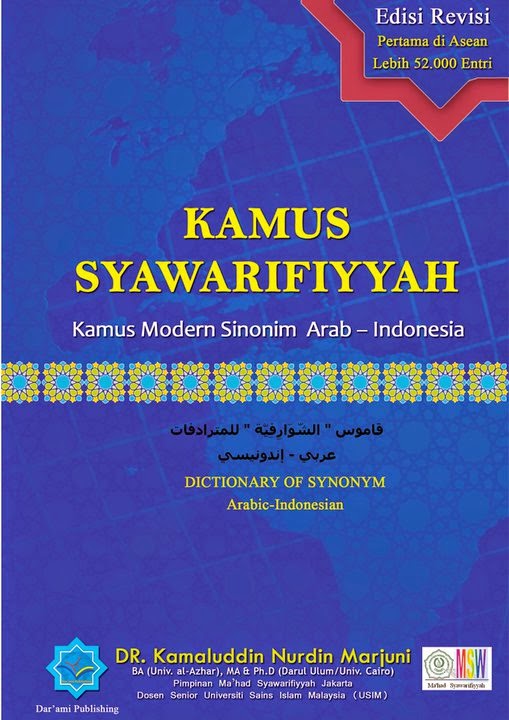

0 komentar:
Post a Comment